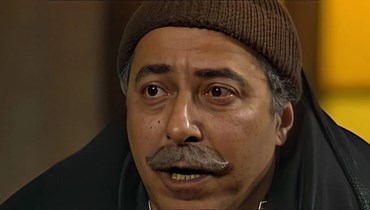عام 2016 المنتهي للتوّ كان غنياً بالأفلام الكبيرة التي ستصمد طويلاً في الذاكرة. أفلام استطاعت الابحار فوق أمواج العالم المتلاطمة والتعبير عنه سواء بالأسى أو بالفرح. أفلام خاطبت الملايين حول العالم، بعضها نال اعجاب الجمهور العريض وتقديره، وبعضها الآخر لمع نجمه في المهرجانات وبين النخبة السينيفيلية. من كانّ إلى برلين فالبندقية، مروراً بالصالات المحلية، سلّمت لنا الشاشة لحظات وأسراراً لا تُنسى، حدّ اننا نستطيع أن نعلن من بعدها ان على هذه الأرض ما يستحق الحياة. في الآتي عشرة أفلام ساهمت في صناعة بهجتنا ودموعنا وقلقنا طوال عام اتسّم سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً بالريبة.
"فوكاماريه" لجيانفرنكو روزي: جوهرة السينما الوثائقية. أول وثائقي في تاريخ مهرجان برلين يتوَّج بـ"دبّ". يحملنا المخرج إلى جزيرة لمبيدوزا التي أصبحت مقصداً لمراكب مهاجرين هاربين من الحروب والمحن. نحو 15 ألف شخص ماتوا على الطريق قبل الوصول الى الجنّة الموعودة. روزي يصوّر أهل الجزيرة، فرق الانقاذ التي تهرع إلى عرض البحر لانتشال الجثث وإسعاف الناجين. يركز التصوير على صبي من هناك في لحظة تتحول فيها حياته مما تشهده أرضه من موت، ولا ينسى الانتباه لامرأة ترتب السرير بدقة. هائل الحنان في نظرته. معالجته هادئة، تولي التفاصيل أهمية. لا يُري الفظاعة بل أثارها على الوجوه، خالصاً إلى درس في صناعة الوثائقي. في لقاء مع "النهار"، قال روزي ان البحر قبرٌ عميق. في رأيه هذه احدى أكبر المآسي التي تواجهها أوروبا منذ المحرقة. لذا، سأل نفسه: كيف نقبل بحدوث هذا؟ الشيء الوحيد الذي كان يستطيعه فيلمه هو خلق الوعي. لا يستعمل روزي التعليق الصوتي ولا المقابلات. يصف الألم الحديث واللامبالاة التي تتأكل المجتمعات الأوروبية. هذا كله، من دون أن يتحوّل آلة دعائية أو أداة للضغط على النقاط الحساسة لاستدرار العواطف.
"صمت" لمارتن سكورسيزي: بعد ثلاث سنوات صمتاً، يعود أحد أكبر السينمائيين الأميركيين الأحياء إلى الشاشة. من حيث السرد والاسلوب وبراعة اليد، هذا أقل أفلامه سكورسيزية. بلا أي نزعة عاطفية، يصوّر مارتي رواية البعثات المسيحية إلى اليابان، من خلال الراهبَين البرتغاليين الانجيليين اللذَين يتعرضان للاضطهاد في اليابان، إلى درجة ان بعضهم سيتخلى عن ايمانه وينكره. هنا غريزة الحكاية أقوى عند سكورسيزي من أي شيء آخر. فيلم قاسٍ جداً، تتسلق القسوة إلى الحلق تدريجاً، وفجأة تخنق المُشاهد. العناصر الطبيعية شخصية وحدها، سواء أكان الماء أم النار أم الضباب، انها بيئة شديدة القسوة لحكاية تُشهر الكثير من الأسئلة المتعلقة بالله والايمان والدين. إلا ان "صمت" ليس فيلماً دينياً يروّج للمسيحية كما قد يعتقد البعض، بل رحلة شاقة بحثاً عن الأجوبة في أرض قاحلة، حيث صرخات العذاب المتتالية لا تلقى أي جواب. سكورسيزي الشكّاك بطبعه لا يبسّط الأشياء، وأعتقد ان هذا فيلم نضجه وحكمته وبحثه المستمر عن أجوبة. للمفارقة، عثر مخرجنا الكبير على رواية الياباني شوساكو اندو خلال وجوده في اليابان لتصوير مشهد في فيلم لكوروساوا، وبعد مشاهدتنا الفيلم يمكن القول ان كوروساوا ما كان لينكر هذا الفيلم نظراً للروعة التي يصور فيها بلاده، وبنمط يقارب نمطه (يبدأ عرضه في بيروت بعد أيام قليلة).
"جنّة" لأندره كونتشالوفسكي: ليس "جنة" فيلماً آخر عن الهولوكوست، بل فيلم بديع بالأبيض والأسود عن الحرب والمآسي ومعسكرات الاعتقال والعقيدة النازية، يحمل في داخله مخزوناً هائلاً من الانسانية. انه لقاء ثلاثة أقدار خلال الحرب العالمية الثانية: روسية من عائلة نبلاء انخرطت في المقاومة الفرنسية، متعاون فرنسي مع النازيين وضابط نازي رفيع المستوى. الحوادث المتلاحقة ستوصل الروسية إلى معسكر الاعتقال حيث تلتقي بالضابط. الضابط هذا مخلص أشد الإخلاص للمشروع النازي. تكمن قوة الفيلم في النحو الذي يرسم فيه السيناريو صورته، وهي صورة قد يجدها البعض إشكالية، كونها حمّالة أوجه. فهذا الضابط يتماهى مع الشر معتقداً أنه يقوم بعمل إيجابي من أجل الإنسانية، ثم عند الحشرة يقول إنه ليس عليه أن يبرّر خياراته. تضعنا المقابلات مع الشخصيات الثلاث التي تدور عليها الحكاية برمّتها في مواجهة معها. انها أشبه باعترافات وتعليقات على خيارات هؤلاء. مشاهدة الفيلم تجربة قاسية تتطوّر لتكون رقيقة في أحايين كثيرة، وهو في المقام الأول عن ورطة العيش في زمن الأفكار القاتلة التي لا تترك أحداً منتصراً.
"هي" لبول فرهوفن: سيدة ستينية (ايزابيل أوبير) تتعرّض للاغتصاب في بداية الفيلم، إلا أنّ الحدث يأخد منحى مختلفاً عمّا نتوقعه، مع "المتعة" التي تجدها في "المحنة" التي تعرّضت لها، حدّ أنّها ترفض رفضاً قاطعاً الخضوع للاجراءات القانونية ورفع شكوى عند الشرطة. رغم سنواته السبع والسبعين، لم يملّ فرهوفن الاستفزاز الذي كان دائماً على موعد معه في أفلام مثل "ستارشيب تروبرز" و"فتيات الاستعراض" و"غريزة أساسية". نصّه ينتهك القوالب الاجتماعية المعمول بها، وقد فاز بجائزة الـ"غولدن غلوب" يوم الأحد الفائت في فئة أفضل فيلم أجنبي، علماً انه لم يجد ممثلة أميركية تقبل تجسيد الشخصية، فأسندها إلى أوبير التي نالت عن دورها "غولدن غلوب" أفضل ممثلة. جمال الفيلم يكمن في أنّ فرهوفن يصوّر هذا كله بلا أي مقاربة أخلاقية. نحن هنا إزاء سينما منحرفة، تقول كلمتها وتمشي، لا تشرح ولا تعلن موقفاً ولا تدين ولا تبرّر، ولا شيء آخر من كلّ الذي ترتكبه بعض السينمات التجارية.
"أكواريوس" لكليبير مندونثا فيلو: مئة وأربعون دقيقة من مشاهدة باهرة. كلارا هي آخر قاطني مبنى أكواريوس المهجور حالياً الذي شُيِّد في الأربعينات. مُضارب عقاري يريد إخراجها مقابل عرض مغرٍ. لكن شقتها في ذلك المبنى تعني لها الكثير من الذكريات والحنين. إلى أين يمكن أن يصل خبث الرأسمالية لتحقيق هدفها ومعاقبة كلّ ما يعترض طريقها؟ عمل رقيق تتدفق مشاهده كالنهر، عن الرأسمالية اللطيفة الودودة التي تتبنى لغة البساطة والشفافية. لكن كلارا سعيدة لمناكفتها. هي التي انتصرت على السرطان، تجدها مستعدة لكلّ شيء. الانتقال بين مراحل حياتها حادٌّ على غرار حديّة وجهها الذي يكتنز أسراراً كثيرة سنفككها شيئاً فشيئاً كلفافة الصوف. "أكواريوس" فيلم سياسيّ بلا أي خطاب سياسيّ، كلّ شيء ضمنيٌّ، نصّ متماسك مشبّع بالموسيقى عن الذاكرة والمرض والحبّ والوفاء وماذا يعني أن تكون امرأة من دون سند عاطفي في متروبول بزمن يشهد على تحوّل.
"مانتشستر على البحر" لكينيث لونرغان: ذروة السينما الأميركية المستقلة. ذروة التمثيل والتقطيع والاخراج والعلاقات المتداخلة الصعبة المعقدة التي يربطها كينيث لونرغان بمدينة مانتشستر الأميركية، لتصبح هي الشخصية الأساسية. ليس من السهل التعامل بباطنية مع مواضيع مأسوية كالفقدان والعزلة التي تعيشها الشخصية التي يجسّدها كايسي أفلك (نال عنه "غولدن غلوب" أفضل ممثّل في دور درامي). لونرغان، سيناريست خطير، يضع فيها يده البارعة. لكن الفيلم يحتاج إلى مشاهدة صبورة وبال طويل. هناك مشهد طويل من نحو عشر دقائق في منتصف الفيلم تستعيد فيه شخصية افلك فصلاً من ماضيه؛ مشهد منحوت بموسيقى هاندل. فعلاً شيء نادر.
"المرأة التي غادرت" للاف دياز: عمل كبير نال عنه المخرج الفيليبيني جائزة "الأسد الذهب" في البندقية. ملحمة سياسية واجتماعية وأخلاقية مدتها 2244 دقيقة. مدرّسة خمسينية أمضت سنواتها الثلاثين الأخيرة في معتقل بسبب جريمة لم ترتكبها، وعندما تخرج إلى الحرية، تصمّم على الانتقام من الرجل الثري الذي كانت على علاقة به وتسبّب بسجنها. دياز يجعلنا نشعر بروحية المكان ووطأة الزمن، حيث كلّ وحدة تصويرية تنطوي على كمّ هائل من السينما الكبيرة، السينما الواقعية التي لا تساوم وتنقل حكايات الناس المهمّشين المنسيين المتروكين لفظاعة المصير. نحن ازاء درس مزدوج في السينما والإنسانية!
"أرض اللا لا" لداميان شازل: فيلم يتسبّب بالكثير من البهجة، يذوب في الحلق كقطعة بونبون. نال 7 جوائز "غولدن غلوب"، إلا ان ما يعانيه هو ما يعانيه معظم الأفلام: المادة الشحيحة التي لا تساعد كثيراً على تشكيل فيلم من ساعتين، لذا يفضّل قبوله كما هو. فيلم عن التسكّع في الجزء الأول، في حين يقارب الشقّ الثاني دراما أكثر كلاسيكية وتماسكاً مع لحظات استعادية وحبكة وخاتمة. كل مقاربة شفهية للفيلم محكومة بالفشل: كأي ميوزيكال، يجب التقاط التفاصيل بعينين واسعتين، انها تجربة بصرية كاملة، بما لها وعليها. شازل يدفع بالموارد السينمائية إلى مداها الأبعد، عبر مشاهد قصيرة، لغة مختزلة، صورة حنونة. يمرّ الفيلم بحالات اغماء كثيرة، ثم ينتعش، حتى انه يحتضر لحظات ثم يعود، ثم يموت ثم ينبعث من جديد. هذه الحيوية جزء من جماله وكينونته التي تمتاز بشيء من الصبيانية المحببة، إلا انها لا تذعن للسهولة قطّ. يمدّ شازل يده إلى السينما فيستعير منها بحريّة. واضح أنه يهضم ما استعاره، الإحالات على أفلام معروفة غير قليلة. الموسيقى هاجس عنده منذ فيلمه السابق "ويبلاش"، هناك ميوزيكالية ما حتى في لحظات الصمت العابرة. عن الطموح والأحلام المكلومة والوصولية والمساومة وحياة الفنانين الهامشيين في هوليوود الذين ينتظرون فرصة في أي لحظة، يأتينا "لا لا لاند" بفيلم "مقصّر" يرضي الجمهور العريض، متضلّع تقنياً وباهر استيتيكياً (التقاط مَشاهد: لينوس ساندغرين)، ولكن في الوقت عينه مثقل بسجالات لا يعالجها إلا ربع معالجة، ذلك أنّ الميوزيكال ليس المحل المثالي لهذه الهموم.
"توني ايردمان" لمارين اديه: اينيس، سيدة أعمال أربعينية مقيمة في بوخارست، تعيش فجأة اقتحام والدها لحياتها، منتهكاً خصوصيتها ومتسللاً إلى أشيائها وشؤونها، هكذا من دون استئذان مسبق. ظاهرة نادرة في مجتمع غربي يمنح الأبناء مسافاتهم الخلاقة من أهلهم. السيدة التي لم تفكّر يوماً في تساؤل "هل أنا سعيدة؟"، تبدأ تحت الضغط الأبوي وأمام حنانه الهائل وازعاجه، بطرح بعض الأسئلة الطارئة. إنه انفجار من الأحاسيس الدفينة في هذا الفيلم الذي يتماهى مع سينما النقد الإجتماعي اللاذع من دون أن يتوصل إلى أن ينتمي إلى هذا الصنف كلياً. فكلّ شيء يعبَّر عنه بنصف كلمة، ونصف نظرة، الخ. هذه هي بإيجاز شديد، الخطوط العريضة لملحمة أسرية شديدة الخصوصية. منذ عرضه في مسابقة كانّ الأخير، كان الفيلم محلّ اشادات كثيرة، إلا ان عدم فوزه بأيّ جائزة دعم صيته في العالم، فوجدناه في معظم لوائح النقّاد، وصولاً إلى ترشيحه إلى الـ"أوسكار" في فئة أفضل فيلم أجنبي.
"سولي" لكلينت إيستوود: فيلم يحبس الأنفاس. مذهلةٌ قدرة ايستوود على اختزال أميركا من خلال حكاية تكشف العديد من جوانبها. كلّ هذا، مستعيناً بحادثة عرضية لم تدم إلا ثواني. وما ادراك ما هي تلك الثواني؟ ما يسرده هنا إيستوود ببراعة لا مثيل لها، هو حكاية الطيّار سولنبرغر الذي استطاع أن يهبط بطائرته بعد تضررها نتيجة دخول بعض الطيور في المحرّك، على نهر هادسون من دون أن يتسبب بأي خسارة في الأرواح. إيستوود عبر ممثله توم هانكس الذي يضطلع بدور سولي، يعيد تركيب كلّ تفاصيل الحكاية، بدقة يستقيها من شخصية القبطان ونظراته وكلامه المنضبط، ليتيح لهذا البطل العادي أن يخرج من الظلّ إلى الضوء. إلا ان لجنة التقصي ووسائل الاعلام ستطارده وستتسبب له بوجع في الدماغ. كلّ مكوّنات الفيلم الأميركي الكلاسيكي هنا، إلا ان عبقرية إيستوود هي في استغلالها وتعطيل بنودها وتوظيفها لمصلحة طرحه المناهض للسلطة ولأساليبها في تجريد الرجل العادي من إنجازه ولحظة تميزه.


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية