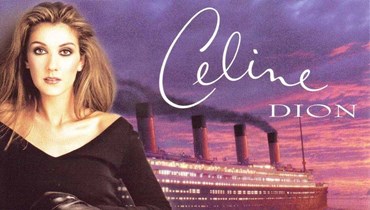أصغر فرهادي يصوّر أفلامه كمَن يقود سيارة
بستة أفلام، و"البائع المتجول" الذي تسابق على "سعفة 2016" هو السابع، استطاع المخرج الايراني القدير أصغر فرهادي أن يفرض نفسه كأحد صنّاع سينما ذكية ورهيفة تفتح الأبواب المغلقة نصف فتحة (هذه الصورة سنراها بحرفيتها في جديده)، بحيث يجد في هذا الاسلوب التعبير الأفضل لطرح أفكاره. يقدّم فرهادي سينما متمهلة تأخد وقتها لتتشكل ملامحها، وعندما تحادثه يتكلم عن عمله بحذر الشاعر الذي يخاف كشف أسرار كتابة القصيدة، أي انه لا يريد أن يقول الكثير كي لا يتطاير الغموض.
"أي حكاية تختارها لنقلها إلى الشاشة"، كان يقول فرهادي في مقابلة مع "النهار" أيام "انفصال"، يُمكن معاينتها من زوايا ووجهات نظر مختلفة. دائماً، أحاول أن أضع قبضتي على حكاية جيدة، حكاية تلائم تطلعاتي، ثم أنسج فيها آفاقاً عديدة، فاتحاً تلك الحكاية على احتمالات معقدة. كيف انتهى بي الأمر إلى انجاز مثل هذا الفيلم؟ هذا، تحديداً، ما لا أستطيع أن أرويه لك. دعني أقارن الأمر بقيادة السيارة التي تجعلك تقوم بعمليات عدة في وقت واحد، كالضغط على البنزين والفرامل وتبديل سرعة علبة التروس، وهذا كله، تفعله من دون أن تفكر في كلّ عنصر من العناصر على حدة، وسيكون صعباً عليك لاحقاً أن تشرح ما فعلته تفصيلياً لتصل إلى مثل هذه العملية: قيادة السيارة".
يبدأ الفيلم بمشهد مبنى متصدع في طهران آيل للسقوط في كل لحظة. فيما سكّانه يهربون من منازلهم خوفاً على أنفسهم، تركّز الكاميرا على رجل وزوجته، عماد ورنا، وهما ينقذان ما يمكن انقاذه، قبل ان تطلّ من نافذة احدى الشقق، لنرى حفّارة تعمل على وضع أسس مبنى محاذٍ في طور التشييد. في المقدمة الطويلة، سنتابع بحث الزوجين عن مسكن. تفاصيل كثيرة يفرضها علينا سيناريو فرهادي المتماسك جداً (يستحق جائزة السيناريو)، فندخل حميميتهما كما ندخل وعيهما. فجأة، يحدث ما ليس في الحساب: يدخل أحدهم على الزوجة فيما هي تستحم. ماذا سيحدث تحديداً وكيف ولماذا؟ عن كلّ هذه التساؤلات التي سترافقنا لن يردّ فرهادي، مفضلاً اللبس والاختزال والخيال، والأبواب نصف المفتوحة. لا شرح ولا تحليل، كلّ الانفجارات تحصل في الداخل، داخل الشخصيات، وتبقى في الباطن، ولا سبيل لبلوغها.
هذه الحادثة العرضية، ستحدث فوضى نفسية باطنية، فتتحول إلى كرة ثلج تجرف على طريقها بعض المسلّمات، وتسقط بعض الأقنعة، وهي تسقط فقط كي تعود إلى الوجوه مجدداً، ليتظاهر الكلّ في الختام كأن شيئاً لم يحدث. "البائع المتجول" هو عن هذا الانكار، انكار الوحش في داخل الكائن. طبعاً، كلّ شيء يصوغه المخرج هنا على طريقته الخاصة، فهو يجيد كيفية امرار الأفكار، ضمناً وليس علناً، ويلتزم خطه هذا حتى عندما يقول ان فيلمه هو ادانة للرأسمالية المتوحشة، او عندما يأتي على ذكر الرقابة خلال تمارين مسرحية "موت بائع متجول". فعماد ورنا يؤديان دورين في مسرحية آرثر ميللر الشهيرة، وهذا ليس تفصيلاً باهتاً، اذ ان حال إيران اليوم من وجة نظر فرهادي شبيهة بحال "أميركا الرأسمالية والعدوانية أمس"، زمن المسرحية.
كي يترجم نقده هذا خطاباً بصرياً، تكفي فرهادي لقطتان أو ثلاث للفورة العمرانية في طهران. ثم يحيلنا المسرح في الفيلم على التكاذب الاجتماعي، على النفاق الذي لا يطاق، على الأقنعة التي يختبئ خلفها البشر، والأهم: المغفرة، وكيف يتحوّل المعتدى عليه إلى معتدٍ. ذلك ان قصة دخول رجل غريب البيت ستكبر، اولاً في رأس الزوج، لمعرفة مَن الشخص الذي تسلل إلى الشقة في غيابه للاعتداء على زوجته؛ وثانياً في الفيلم نفسه اذ يتبين ان الشقة كانت تسكنها سابقاً عاملة جنس والمعتدي هو زبونها. هذا كله سيفتح الباب وسيعاً أمام مجموعة مشاعر متضاربة، لن يستطيع الزوج تجاوزها ولا التصالح معها.
"البائع المتجول" يصبح في جزئه الأخير مرافعة ضد الانتقام الذي يسعى اليه الزوج، وستجري فصوله في الشقة القديمة المهجورة التي تتهاوى، مع كلّ ما يحمل ذلك من رمزية. لا نريد كشف المزيد عن فيلم ينطوي على تشويق، وهذه اضافة جديدة على عمل فرهادي المشغول بحكايات أخلاقية يستقيها من عمق المجتمع الايراني. هنا، نقد لاذع للمجتمع، مع انه لن يتحقق بالكلمات بل بالانزلاق التدريجي في الهاجس الانتقامي الذي سيحوّل رجلاً عادياً إلى شخصية سينمائية. بحساسية مفرطة، يصوّر فرهادي ثريللراً بسيكولوجياً يحبس النفس في الجزء الأخير منه. يطرح نفسه كأحد اساتذة الاخراج وكتابة السيناريو في السينما الحديثة، معتزلاً داخل جدران القسوة والضغينة، الا ان هذا لا يمنعه من أن يكون معلماً تنويرياً ينظر إلى العالم على نحو يضع الطبيعة البشرية في قلب هواجسه.
جزء كبير من نصوص السينما الايرانية يتضمن كثافة حوارات، كأن الأمر عبارة عن رياضة كرة مضرب بين شخصين. لا تبدو أفلام فرهادي خارج هذه الاسلوبية. يقول: "نعم، صحيح ان السينما الايرانية تنطوي في معظم الحالات على الكثير من الحوارات، والأخذ والردّ، كونها سينما قائمة على ردّ الصاع بالصاع، ذلك ان هذه الحوارات تساعد السينمائيين في الحصول على حالات دراماتيكية فيها الكثير من التشنج. السؤال الذي يواجهه جواب، دائماً ما يولّد طاقة دراماتيكية لا مثيل لها. لطالما، حاولتُ أن أطرح أسئلة بدلاً من الاتيان بأجوبة جاهزة. السبب في ذلك انني لم أكن أكيداً من ان اجوبتي قادرة على ارضاء الناس. لهذا السبب، لم تحرك فيّ مسألة البحث عن حلول أي احساس. ثم هناك حقيقة أخرى وهي أن هناك حلولاً بقدر ما هناك من مشاهدين، والحلول التي يتوصل اليها بعض المشاهدين قد تكون افضل واعمق من حلولي".
شخصيات أفلامه يلفها الغموض. لماذا يرفض اعطاءنا المزيد من المعلومات عنها؟ يقول فرهادي انه يفضل الا يمنح الكثير من المعلومات عن شخصياته، فهذا أشبه بالحياة الحقيقية التي نقيم في داخلها. في كل حال، حتى نحن، لا نعرف الكثير عن أنفسنا. "اذاً، والحال هذه، تجدني أكتفي بتقصي المعلومات التي ترغمني على منحها الحالة التي تجد شخوص فيلمي أنفسهم فيها".
يؤكد فرهادي انه لم يتوقف يوماً عن صنع الأفلام التي أرادها، على رغم الصعاب التي يتعرض لها مخرج في بلد مثل ايران. "لكن، هذا عن ماضينا، اما عن المستقبل الذي ينتظرنا، فهذا لا استطيع أن اقول عنه أي شيء. أؤكد ضرورة أن نحظى بحرية التعبير. هذا شيء في منتهى الأهمية والضرورة في سبيل تعزيز النشاط السينمائي. حتى خارج الاطار السينمائي، نحن في حاجة الى حرية كي نتنشقّ الهواء. بصراحة، لستُ سعيداً بهذا القدر من الحرية في ايران، ونحن أحوج ما نكون الى توسيع الهامش المعطى لنا، لأنه اساسي لخلقنا ووجودنا.
هناك مَن يريد فقط متابعة القصة في افلامي أو فهم خيوطها وتفاصيلها. لكن في المقابل هناك من يبحث عما يختبئ خلف الستار، ويحاول أن يسترق النظر الى الداخل. عموماً، أميل الى المُشاهد الذي يبحث عن أجوبة لأسئلة يطرحها على نفسه، أكثر مما أميل الى الذي يستقبل كل ما يشاهده بلا تفاعل".
رداً على سؤال "هل تعتبر السينما الايرانية مصدر الهام؟"، يقول فرهادي: "السينما الايرانية ذات النوعية الفنية العالية هي التي أثّرت في بداياتي. لكني لا استطيع ان أجزم اذا كنت انتمي اليها تراثياً. لكن، بما اني ايراني، فهذا يعني ان الفيلم الذي انجزته ايراني الجنسية، ويعتبر ايرانياً مثل غيره من الأفلام الايرانية. التأثيرات اختلفت بين فترة واخرى من حياتي. في فترة الدراسة الجامعية، كنتُ معجباً بإثنين: كيسلوفسكي وتاركوفسكي. في مرحلة ثانية، عناني ايليا كازان الكثير. حالياً، انغمار برغمان، وفي مرحلة سابقة كان فيديريكو فيلليني. هناك تشابه بين الوضع الايراني الحالي والظروف الاجتماعية التي كانت قائمة في ايطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. لهذا السبب نحن السينمائيين في ايران، نشعر بأنفسنا مقربين من فيتوريو دو سيكا وبيار باولو بازوليني مثلاً".


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية