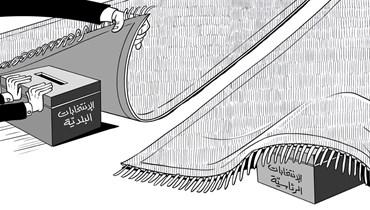... واسمها تدمر. في جلجلة الصحراء قالت مرّة: أنا تدمر وتدمر أنا، كلانا روحان حللنا صُفرةً شاهقة وممتدة تارة، وطوراً نخيلاً. كان ذلك في نيسان 2004، عندما وصل إلى سوريا، وفدٌ من إسبانيا، مكوّن من أطباء وطبيبات، بعضهم جاء برفقة عائلته وأطفاله، لغرض المشاركة في مؤتمر طبّي في العاصمة دمشق آنذاك، حسبما قيل. يبدو أن خطّة سياحية، من شأنها الترفيه عن الوفد هذا، من خلال زيارة مواقع أثرية في أماكن مختلفة من سوريا، من مثل قلعة حلب وقلعة سمعان ونواعير حماة وأفاميا وتدمر، كانت مقرَّرة لنحو أربعة أيام، وكانت هناك حاجة إلى صبايا لمرافقة الوفد المقسَّم مجموعات موزَّعة على بولمانات عدة. طُرِحت الفكرة على تدمر من زميلات. رفضتْها في البداية: "شو خصني أنا يترفهو أو ما يترفهو!"، فكان الرد: "منجرّب. على الأقل منشتري بالمرتّب كتب الجامعة، ومنشوف مواقع أثرية ببلدنا بعمرنا ما شفناها". كان أصل الحكاية إذاً، شُغلاً محضاً، أثار الجانب الاستهلاكيّ فيه، اشمئزازاً في نفس تدمر ذات الكينونة غير الموائمة للأمور التجارية. وكما أن الأطفال لا يجيدون في العادة، الارتجال، لحظة الوقوع في خطأ ما أثناء التمثيل، على الرغم من كونهم مرتجلين بارعين على مسرح الحياة؛ كانت تدمر كذلك، لا تجيد ما يتطلّبه هذا الشغل من ارتجال سريع البديهة أمام المطبّات الكثيرة التي لا بدّ أن تحصل في أثناء تمثيل الاهتمام والابتسام، وتقديم الورد الذي هو نقد (عملة). في معمعة ترّهات الشركات السياحية ومهرجانات السمسرة، والإغواء النسويّ المبتذل من جهة، والتزمّت النسوي المبتذل من جهة أخرى؛ كانت تدمر تشعر بأن الرابح يبقى وحيداً وبعيداً لكن منتبِهاً (ربما لأن قدَرَه أن يكتب في ما بعد). كان الأصل في الحكاية شُغلاً محضاً، قبل أن يتحوّل بالنسبة إلى تدمر، رحلةً شيّقة، ولقاء إنسانياً مهمّاً، وكشفاً معرفيّاً هائلاً. إذ للحياة معانٍ أخرى لا تُحصى، غير شهوة المال والسلطة والشهرة. "المصاري بتروح وبتجي"، لكن ثمة "أشياء"، ليس من شأنها أن تروح ولا أن تجيء. في الطريق إلى تدمر، سُئل "الدليل السياحيّ" عن أسباب انوجاد هذا الكائن إلى جانب أبيه في كل مكان، فأجاب السائلين من الإسبانيين الذين يتقنون اللغة العربية: "ما بحب الأسئلة الصعبة". الدليل السياحي هذا، الذي يمتشق أساساً مهمة صعبة، ينبغي له من خلالها أن يجيب عن الاستفسارات السهلة والصعبة كلّها في ما يخص الآثار، كان صعباً عليه أن يجيب عن سؤال من هذا الطراز. لم يكن صعباً، بقدر ما كان شاقاً وشانقاً. في الطريق أيضاً، كانت هناك استراحة، عرض فيها أحد أطباء الوفد الإسبانيّ ما يُسمى بـ"الإكراميّة"، على بدويّ، لقاء خدمة أدّاها الأخير له. رفضها البدويّ. سأل الطبيب، الدليل السياحي نفسه، عن سبب الرفض هذا، فأجاب: "البدوي الحقيقي الأصيل لا يقبل إكرامية من أحد. يرى في ذلك إهانة لكرامته وكرمه. هو يأخذ حقّه فحسب حين يعمل، من دون أدنى اعتبار للمال "البرّاني"، وحين يؤدّي خدمة لا يأخذ مقابِلاً. ردَّ الطبيب مشكِّكاً، مشيراً بإصبعه إلى أحدهم: لكن ذاك الرجل أخذ "إكرامية". فقال الدليل بنبرةٍ واثقة: "هذاك نَوَري مو بَدَوي" (هناك، في ذاك الجبل، درجت عادة الغالبية الساحقة على قولٍ مطبوعٍ بـ"حُكم مسبق" وبالهاجس الدائم في اصطناع الأعداء حتى لو لم تكن ثمة حاجة إلى ذلك: "نحنا مِحْنِتْنا من البدو"! لتحييد العدوّ الحقيقيّ ربما. درجت العادة أيضاً على الابتهاج، كلّما صادف ومرّت في الحياة، عائلة ما بدوية كريمة لا تبخل بما قد يتوافر لديها من لبن وجبن وزبدة وسمن أصلي). أما إحدى طبيبات الوفد نفسه، من اللواتي لا يفقهن اللغة العربية، فقد أومأتْ لتدمر حين رأتها تشمّ زهرة قطفتها للتوّ؛ بما يفيد التحذير من أن تُصاب بالزكام. استعانت تدمر التي بدورها لا تفقه اللغة الإسبانية، بالدليل السياحي، لكي يوصل إلى الطبيبة الآتي: "أنا مستمتعة. لكن شكراً جزيلاً لحرصكِ واهتمامكِ".
* * *
كان الليل قد جنّ، عندما وصل الجميع إلى تدمر. وبأصوات تصدح بأغنيات تقليدية محلّية، وبقرع الطبول الذي على أشدّه والدبكات الشعبية؛ استُقبلوا في خيمة بدوية كبيرة مقسَّمة أقساماً عدة، مفروشة بـ"الفجّات" و"الطرّاحات" و"المخدّات" الصوفية المحوكة بأيادٍ وبروح بدوية خالصة، وعامرة بالقهوة العربية وبالموائد والأكلات الشعبية البدوية الشهية. على الرغم من سحر ما كانت الخيمة ممجوجة به، وحماسته وصخبه، كانت النساء الإسبانيات، باردات غير متفاعلات إلى حدٍّ ما. صبيّتان فقط، من بين نحو خمسين امرأة من ذوت الأعمار المتفاوتة، شاركتا في الدبكة قليلاً، وثلاث فحسب تفاعلن بنقرٍ خفيفٍ بالأصابع على طاولة خشبيّة أمامهن، وبتلويحٍ هوائيّ أقلّ خفّة بالأيادي البيضاء. وحدهن الصبايا السوريات، كنَّ مفعمات، متمايلات كسنابل قمح في يوم صيفيّ عاصف بريح ساخنة. وكان حاضراً بقوة، ذاك السؤال الوثيق الصلة بـ"الأحكام المسبقة"، عن "الروح الغجرية" الغائبة. كانت تدمر غائبة في عتمة الليل، وثمة شوق عارم للقاء جمالها صباحاً. للتعرّف إليه عن قرب. لتنفّسه. لطالما شوهد في الصور والشاشات فحسب. أشرقتْ تدمر أخيراً، وانهمر السرّ المطير: الأبراج. القصور. المدافن المزدانة برسوم ملوّنة وتماثيل (مدفن الأخوة الثلاثة مثلاً: مالي وسعدي ونعماي 160 م. أو المدفن البرجيّ "إيلا بل" القرن الأول الميلادي). حمّامات زنوبيا. الأغورا (السوق أو الساحة العامة). التترابيل (المصلبة). الشارع الطويل المستقيم الذي تساهم في خطّه أعمدةٌ رائعة من الجانبَين. المسرح. قلعة فخر الدين المعني الثاني. المعابد المحفورة على جدرانها وأعمدتها، أزهار وأشجار نخيل وسنابل قمح (معبد بعلشمين مثلاً. هذا الذي بناه مالك بن يرحاي في القرن الثاني الميلادي). إنها الصحراء مطعَّمة بفنّ ذهبيّ مذهل. ناهيك بالمَزارع، بأشجار النخيل الباسقة، المشلّقة أغصانها كشلاّلات، المكنوزة بالتّمْر "طعام الشجعان"، مثلما الموز "طعام الفلاسفة" وفق ما يُحكى، وأشجار الرمّان، والزيتون. وبالتحف والمطرَّزات والحلى المشغولة باليد، المعروضة المفروشة في كل مكان. انتقتْ تدمر لنفسها من الحلى تلك، عقداً من الخرز الأحمر القاني، زيّنت به العنق مباشرة. أهدته لاحقاً إلى سيدة إسبانية أحبّتها وطفلتها ذات السنين العشر. كان الإهداء بمثابة إجابة فورية عن رغبة السيدة في منحها "إكرامية". تعلّمتْ تدمر من السيدة نفسها، جملاً من مثل: "كومو كيراس" (سِرْ مثلما تريد). تكرَّرت الطريقة في الإجابة، عندما عرض عليها طبيب إسبانيّ، "إكرامية"، في معبد "بل". التقطتْ تدمر آنذاك، حجراً صغيراً من الأحجار الكثيرة المتناثرة في ساحة المعبد أمام الأعمدة التاجيّة الممهورة بخطوط طولية نافرة، نازلة مثل صرامة قدَر من الأعلى وحتى النهاية في الأسفل. أحاطت الحجر بأصابع يدها حتى كادت الحرارة تستشيط منه ناراً، ثم قدَّمته إلى الرجل بعدما أوصته بأن يحتفظ به دائماً. حالِمة في عالمٍ لا تكون فيه "الإكرامية" مقابِلاً للطف الإنسانيّ البحت (ترى مَن يراوِد مَن، نحن أم الحُلم؟).
بين شعلتَي غزَل، انحازت تدمر، إلى ذاك الشاب البدويّ الأسمر، صديق الجِمال والجَمال، آخذةً معها حكمة شفاهية من حامل الشعلة الأخرى، وهو شاب إسبانيّ يجيد العربية، أعطاها إياها حين غازلها، فاحمرّت الوجنتان وأُخفِض النظر: "بتعرفي شو بينقصك؟ بينقصك ثقة بنفسك. مرّة تاني بس حدا يقلّك إنك حلوي، قليلو: إي شو يعني! بعرف إنّي حلوي".
انحازت إلى البدوي الأسمر، مدفوعةً بحُلم شبابيّ في إنقاذ العالم. تحسينه. تغييره. بحُلم إحقاق العدل الذي يعني هنا: لا ضير في أن تنشقّ، ولو امرأة واحدة فقط، عن طابور النساء المتقاطرات المتهافتات على الشبّان ذوي المكانة المرموقة اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً، لصالح شاب جدير لكن مهمّش مالَ إليها. أيضاً البدوي الأسمر أعطى تدمر حكمة، لكن مكتوبة هذه المرة، على الوجه الخلفيّ لصورة جذع نخلة يشبه أناناسة ضخمة. كانت الحكمة عبارة عن شقّين: "الحياة ليست كتابة وقراءة فقط. لكن حُبّ وعطف أيضاً"، و"في عينيكِ، لا بد لكل طير سجين أن يتحرر، لكي يتنشق الهواء النقي، ولكي يعرف معنى الحرية، وأن لا يُقتَل كل شيء جميل موجود في الدنيا" (الأدراج والأبراج فاضت بحِكَمٍ، كان يمكن تدمر أن تشرع في بذرها حكمةً في إثر حكمة، عميقاً في رحم الأكوان المجرَّفة بسيخ العسكر و"العشّاق" الكذَبة، إضافة إلى الرأس المبذورة فيها أصلاً، لولا ذاك الشعور الممضّ بأنها لم تكن مصيرية يوماً. حِكَمٌ حِكَم والكلّ سائح. وحدها الأميرة، تذهِّبُ الصحراء معابدَ فنٍّ، وتخضِّرُها حكمةً.
6 نيسان2004. انتهت الرحلة.
* * *
قبل أيام، بينما كنت أقرأ في تقريرٍ لـ"معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث" يعود تاريخه إلى 23 كانون الأول 2014، أنَّ الدمار والأضرار الجسيمة، قد طاولت نحو 290 موقعاً أثرياً في سوريا جرّاء الحرب الدائرة فيها، منها مواقع في الرقة وبصرى وتدمر وغيرها؛ أخذني التقرير مباشرة إلى رحلة تدمر تلك. وفي القلب حرقة حيال كل شيء، خصوصاً عمرنا الذي يُحرَق في الحرب المفتوحة هذه. تأمّلتُ في ما كان يقوله لي شقيقي قبل أيام أيضاً: "نقرأ الآن على سبيل المثل عن حرب طروادة خلال أربع ساعات أو أكثر بقليل. بمتعة نقرأ عن حربٍ استعرت في الحقيقة عشرات السنين، ممهورة بالأوجاع البشرية الهائلة، ولا شك في أن ثمة هائلين صُنع التاريخ على جثثهم، مكتومون في صفحات التاريخ لا نعرف الآن عنهم شيئاً. بعد مئات السنين، سوف يقرأ القادمون عنّا، عن ثورتنا، عن الحرب هذه، خلال بضع ساعات. سيقرأ القارئ القادم تاريخنا بمتعة ربما. لكن التاريخ الآن يسير، يصير، يُصنَع، يُقلَّب ويُقلى على جثتي. على جثثنا".
*كاتبة سورية


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية