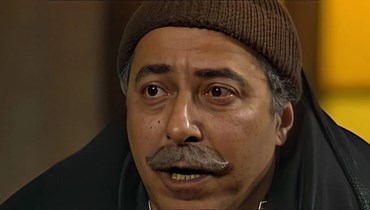لماذا جبران خليل جبران؟
أصدرت "دار نوفل" مجلّدَين أنيقَين يضمّان أعمال جبران الكاملة، وقد رأيتُ في هذه البادرة شيئاً حسناً للغاية. ليس لأن الإصدار كان أنيقاً، ولا شغفاً بالأيقنة والأسطرة اللتين تلقيان بظلالهما على صورة جبران وأدبه، بل "لغاية في نفس يعقوب". إذ يعنيني، حصراً، على هامش هذه المناسبة، بل منذ ليلة القبض على لبنان (تيمناً بعنوان فيلم لفاتن حمامة)، أن يقرأ اللبنانيون، قادتهم السياسيون، زعماؤهم الدينيون، وحرّاس المجتمع والثقافة والتربية فيهم، مضمون ما تنطوي عليه كتب جبران، في الحقّ، والحرية، والقوانين، والقيم، والمعايير، والعدالة، والأنسنة، والأخلاق، والانتهاز، والسياسة، والمجتمع، وأيضاً في الدين.
أطلب من هؤلاء أن يتصفحوا هذه الكتب تصفحاً أفقياً فحسب. أُقسِم بأنهم لن يجدوا صعوبة كبيرة في فهم معانيها واستجلاء دلالاتها ومراميها. وإذا وجدوا صعوبةً كهذه، ففي إمكانهم أن يطلبوا من مستشاريهم الثقافيين الكُثُر تلخيص هذه المعاني في صفحة واحدة، لا أكثر ولا أقلّ. ففي صفحة واحدة، يستطيعون تظهير لبّ "أجنحته"، "أرواحه"، "عواصفه"، "دمعته وابتسامته"، "بدائعه وطرائفه"، "عرائسه"، "مواكبه"، "مجنونه"، "يسوعه"، "رمله وزبده"، و"نبيّه". في صفحة واحدة، يمكنهم استنباط معاييره في تدبّر شؤون السياسة والمجتمع والدين، وفي إصلاح هذه الشؤون. أما إذا استنكف المستشارون، وعفّوا عن التلخيص، لعلّةٍ في نفس يعقوب، ففي إمكاننا أن نوقف ليومٍ واحدٍ فقط، أعمال القادة والزعماء من أهل الدين والدنيا، ومعهم النواب والوزراء والإداريون والموظفون والتربويون، ونسأل شاشاتنا الوطنية والثقافية جداً، أن تخصص نهارها وليلها، 24 ساعة فقط، لشرح آراء جبران وأفكاره.
أرجو أن لا أكون أجازف بصدقيّتي المهنية والأدبية والنقدية، إذا قلتُ بنوعٍ من اليقين المتواضع والمتهيّب، إن كثيرين من اللبنانيين، ومن هؤلاء المعنيين، السياسيين والدينيين والتربويين، لم يقرأوا جبران. وإذا كنتُ مغالياً، فلربما قرأوه، ولم يفهموه. وإذا كنتُ قد أصابني شططٌ ما في الاستنتاج، فلربما قرأوه فعلاً، وفهموه فعلاً، وأحبّوه فعلاً. فإذا كانوا قد تداركوا هذا كلّه "عن جدّ"، فليعملوا، والحال هذه، بأقواله. أما إذا لا، فليكفّوا عن امتداحه، وامتداح العبقرية اللبنانية التي أنجبت الأساطير.
في يقيني، أن حال لبنان لم تتغيّر جوهرياً عما كانت عليه عندما أعلن جبران ثورته على أهل السياسة والمجتمع والدين. بل ربما تغيّرت أقنعة هؤلاء شكلاً، لكن وجوههم وقلوبهم ازدادت وقاحةً واسوداداً.
منذ ليلة القبض على لبنان، كان لا بدّ من وضع معايير جبران موضع التنفيذ. لهذا السبب بالذات، لشيءٌ حسنٌ للغاية أن تصدر "دار نوفل" مجموعة جبران الكاملة في مجلَّدَين أنيقَين.
"مين بيعرف؟! بلكي حدا بيصير يقرا، وبيحسّ ع دمّو"!
بل ربما يهبّ مَن يهبّ، ليصرخ مع الصارخين في البرّية، ومع فاتن حمامة تحديداً: أريد حلاًّ!
* * *
لسنين عديدة
تحتفل الجامعة اليسوعية هذه السنة بمرور مئة وأربعين عاماً على تأسيسها. ليس كثيراً أن تبلغ الجامعة هذا العمر. شأن الجامعات أن تعيش أعماراً متواصلة، من خلال قدرتها على استكشاف عناصر ولادتها الجديدة، سنةً تلو سنة، ومرحلةً تلو مرحلة، وامتحاناً تلو امتحان. شأنها أيضاً أن تمتلك الروح والفلسفة والأدوات التي تمكّنها من مخض هذه العناصر، وبلورتها، لتصير هي حقيقة المجتمع ومستقبله ومراياه النبيلة.
أشعر بنوعٍ من الحبّ "العائلي" حيال هذه المؤسسة. شقيق جدّي درس الطبّ فيها. عمّي، أشقائي وشقيقاتي جميعهم تخرّجوا فيها. شقيقي الأكبر رافقها طالباً، ثمّ أستاذاً، ولا يزال، وهو عايش مسيرة إدارتها نحواً من ربع قرن. أنا الذي درستُ في الجامعة اللبنانية، عدتُ فتتلمذتُ في الماجستير والدكتوراه على كاهنَين يسوعيين، عالمَين وجليلَين. فكيف لا تملأني مشاعر "عائلية" كلما جئتُ على ذكرها!
أغتنم هذه المناسبة المهيبة والسعيدة، لإثارة السؤال حول معنى الجامعة، كلّ جامعة، ومسؤوليتها، ليس في تخريج الأجيال، بل في نقدها لذاتها، وفي تجديد الامتحان الجوهري الذي يتعلّق بدورها المركزي في خلق الأفكار، وإبداع القيم، واستشراف آفاق العقل، والمساهمة في صناعة الثقافة الإنسانوية، وتفعيل خصوصيتها باعتبارها المكان - المختبر.
ليس لهذه الالتفاتة العابرة أن تزعم القدرة على محاورة الجامعة في معناها ودورها ومسؤوليتها. لكنها تطمح إلى أن تكون محفّزاً إضافياً، يذكّر الجامعة، كلّ جامعة، بأن من واجباتها التاريخية أن تكون كلّ يوم، الآن خصوصاً، العقلَ الذي ستكون عليه الحياةُ غداً.
أقول العقل، مومئاً إلى مسؤولياته التي لا تُحصى، ليس في إنتاج العلوم والآداب والفنون على أنواعها، بل في استشراف المضمر منها، وتحفيزه، وإيصال الكهرباء والمغناطيس إليه. هذا لا يمكن أن يتحقّق إلاّ برؤىً وعقولٍ وأدواتٍ خلاّقة، يجب أن تخترعها الجامعة "بالقوة"، إن لم تكن متوافرة فيها "بالفعل".
للفيلسوف، للعالِم، للطبيب، للمهندس، للمفكّر، للباحث، للمختبِر، للمخترِع، للأستاذ، للغويّ، للشاعر، أن يكونوا، كلٌّ في ميدانه، عباقرةً وخلاّقين. ليس مسموحاً للجامعة بأن تكون أقلّ. امتحان الجامعة، هو هذا الامتحان بالذات. وإلاّ فلتبحث الأجيال، بل الأوطان، عن حصون وملاجئ روحية وعقلية أخرى.
للجامعة أن تؤوي هؤلاء. لهؤلاء أن يمتحنوا الجامعة. وللجامعة أن تستثيرهم، وأن تجادلهم. بل أن تتخطاهم، لتكون مستقبلهم، لا ماضيهم فحسب.
في مناسبة العيد الأربعين بعد المئة للجامعة اليسوعية، هل يكون الواحد منا يطلب الكثير من الجامعة، كلّ جامعة، أن تكون ما يجب أن تكون، في عزّ الحاجة (المفتقدَة!) إليها، وخصوصاً عندما تتساقط الحصون والملاجئ العقلية، واحداً تلو الآخر، في بلادنا؛ هذه التي تُمتحَن الآن، كما العالم العربي، ليس في ثقافتها فحسب، بل خصوصاً في كينونتها ومصائرها؟!
* * *
ليلة القبض على الجامعات
كنتُ في أوّل العمر، عندما كانت ثلاث جامعات كبرى، الجامعة اللبنانية والجامعتان الأميركية واليسوعية (ربما غيرها أيضاً، من مثل كلية بيروت الجامعية للبنات آنذاك، الجامعة اللبنانية الأميركية حالياً)، تؤدي دورها الخلاّق المفترض، وتنتج للمجتمع اللبناني (والعربي) نخبته الفذّة في الفكر والعقل والثقافة والأدب والفن والعلوم والسياسة والزعامة.
كانت هذه الجامعات، هي التي تقود المجتمع، بإيديولوجياته، بأحزابه، بجماعاته، بزعمائه، بأفكاره، وبمواهبه. وهي التي كانت تفتح له الطريق.
أما اليوم، فهل الجامعات هي التي تقود هذا المجتمع؟ لا بدّ أن أردّد على الملأ ما تقوله، في سرّها، البقية الباقية من النخب اللبنانية، في أن الجامعات – ولا تعميم - تُقاد اليوم، لا العكس.
تقول البقية الباقية من النخب اللبنانية: كان ثمة فلاسفة وعلماء وخبراء وعباقرة يقودون الجامعات ويلهمون المعنيين والأجيال على السواء، أما اليوم فثمة – والله أعلم - حرّاسٌ إداريون وحملة وظائف وشهادات ومتنطحون وأصحاب مواهب متواضعة وتجّار وغاسلو أموال ومحاسيب وأهل طوائف وغرائز وأهواء ومصالح وإيديولوجيات وزعماء وميليشيات، هم الذين يقودون لا السياسة والشؤون العامة فحسب، بل بعض الجامعات أيضاً. فكيف يُحفظ لبنان، ويُدارى، ويُدرأ؟!
إنما أنقل فحسب صرخة البقية الباقية من النخب. ومعها، أتأمل خصوصاً حياة المجتمع، ووقائعه، وأدواته، في تدبير شؤون السياسة والإدارة والوظيفة والعقل والتفكّر والثقافة والعلوم والآداب وحياة الناس، فأستنتج ما لا أريد أن أصدّقه، أن ليس ثمة شيء جليل يفسح موضعاً مكرَّماً يسند الأملُ إليه رأسَه في هذه البلاد.
الجامعة (والمدرسة) في لبنان، ليست على ما يرام. ربما لأجل هذا السبب بالذات، لبنان نفسه ليس على ما يرام.
أيتها الجامعة، كوني ما يُفترَض بالجامعة أن تكون، في بيروت الثقافية والطليعية (المفتقدَة!). هذا هو امتحانكِ الرهيب، أيتها الجامعة!
* * *
فاتن
قُبْلتُها، كرسيُّ اعتراف؛ فاتن حمامة.
أكثيرٌ، والحال هذه، أن نحيا بالسمّ الذي على شفتَي الحبر، وبرصاصةٍ في القلب؟!
أستعير لهذا المقال، العنوان المذكور أعلاه، وهو لفيلمٍ من أفلام فاتن، لأخاطب اللبنانيين بالآتي، لكنْ جهاراً علناً: إنما لبنان يؤخذ أخذاً رضيّاً، ككرسيّ اعتراف، وكما ينبغي أن يؤخذ حبرٌ بقبلة!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية