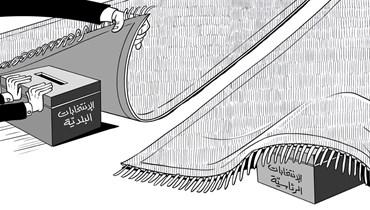يأتي هذا المقال بالتزامن مع معرض بيروت العربي والدولي للكتاب. إنه، والحقّ يقال، مديحٌ سافرٌ للكتاب، أياً تكن أحواله ومصائره، لكنه يحمل في نسيجه هجاءً علنيّاً فادحاً للحياة اللبنانية. فهو يرثي بيروتنا، وحياتنا، مثلما يرثي المرء جسداً كانه، ولم يعد هو هذا الجسد. إذ، كيف لجسدٍ كهذا الذي يسكنه كلٌّ منا، ويأوي إليه، أن يكون جيداً، إذا كانت روحه ممسوخةً ومنخورةً حتى العظم؟! وكيف لحياةٍ كهذه الحياة التي نعيشها، أن تكون سعيدةً، إذا كانت غير مطمئنةٍ إلى خبزها وزيتونها، وأيضاً إلى أحلامها الفقيرة المتواضعة؟! لا أتحدث عن ذاتي الشخصية، بل عن كلّ ذاتٍ مهجوسةٍ بالكتاب، فكيف إذا كانت مهجوسةً بالمعنى الأصلي للحياة نفسها. لهذا السبب يرثي المقال، لا الكتاب، بل الحياة نفسها.
يتوهّم الإنسان الطيّب بيننا أنه يعيش، فيُخيَّل إليه بالظنّ أنه "يحيا"، لكنه مجبرٌ، موضوعياً، كما في كينونته الباطنة، على الاكتفاء "غرائزياً" (أي حيوانياً) بأنه لا يموت، بل يعمل ويأكل ويشرب وينام، في حين أنه لا يتمتع من هذه الحياة إلاّ بقشرتها التي ذكرتُ. هو، في معناه الأعمق، وفي كرامته البشرية المطلقة، من أين له أن يكون يحيا، كإنسان، في حيّزٍ مجتمعي، اقتصادي، سياسي، عام، في حين أن هذا الحيّز لا يملك أن يصون الحياة، بل ينقلب عليها، يشيّئها، يخونها، يشوّهها، يمعسها، يقتلها، يستأصل روحها، ويجعلها محض أداة استهلاكية؟!
إذا كانت هذه هي حال المرء الكريم، فمن أين للحيّز الثقافي أن يعثر على مكانته، ومن أين لكتابٍ أن يحفر وينمو، إذا كان مزروعاً خارج تربته، منفياً من أرضه وفضائه وحيّزه الطبيعي والموضوعي؟!
تستطيع بيروت أن تعود، الآن، لتصبح بيتاً لإنتاج الكتب كلّها. تستطيع أن تستدرج كتّاب العالم العربي كلّهم، ليقيموا فيها، ويكتبوا، ويناقشوا، ويتفاعلوا. تستطيع أن تنتج أكثر المجلات طليعيةً وحداثةً، وأن تكون مختبراً لإطلاق الأفكار التي لا تخطر في البال. لكن هذا كلّه، لن يكون له فاعليةٌ جوهرية، و"كيميائية" (بمعنى الـ alchimie)، تُذكَر، إذا كان الحيّز العام مفرغاً من حصانته. لأنه من أين لهذا كلّه أن يفعل فعله، وأن يتفاعل، ويختمر، ويحفر، وينمو، إذا كانت الحياة العامة (المكان العام) هي نفسها خارج الحياة؟!
عبثاً، نحكي عن الكتاب والكتابة. عبثاً نقيم معارض للكتب، ونحيي الأمسيات، ونعقد الطاولات المستديرة. عبثاً، هذا الهراء كلّه، ما دمنا خارج الحياة.
قال لي أحدهم قبل أيام: لا جدوى من كلّ جهدٍ كهذا الجهد الطائش والذاهب إهداراً. قبل أن تسألني عن الكتاب، فكِّرْ، فقط، في أن الناس يريدون أن يطمئنوا إلى الحدّ الأدنى من أمانهم (رفاههم!) الوجودي، المادي، المتمثل في جملةٍ من المفتقَدات، لا سبيل إلى إرساء أيّ نوعٍ من أنواع الجهد العقلي والثقافي والنقدي، إذا تمّ التغاضي عنها، أو إغفالها، أو القفز فوقها.
وقال لي: نحن لا نعيش. نحن نفتقر إلى الحيّز المجتمعي، الاقتصادي، السياسي، الذي يؤمّن لنا الحيّز الفردي، ويحميه، ويصونه، ويجعله في منأى من التهديد والخطر والهجس الكابوسي. في خضمّ هذا الافتقار الجوهري إلى فاعلية الحيّز، كيف تريدنا أن نبحث في جدوى معرض للكتاب أو في سبل تعزيز القراءة، وسوى ذلك من ترفٍ بات نرجسياً وثانوياً، في حين أن "ترفنا" الأصلي والأساسي، أي الحياة، غير متوافر. بل معدوم.
نريد أن نعيش. نريد أن نعيش في حيّز موضوعي عام، يمنحنا "ترف" عدم الخوف، وعدم الهجس باللقمة، وعدم الهجس بالاقتلاع والتهجير، وعدم الهجس بالموت والمصير.
نريد أن نحصل على لقمة الخبز. نريد أن نأمن يومنا وغدنا. نريد أن نكون سعداء، في الحدّ المتواضع والخجول والخفِر لمعنى السعادة.
قبل تحقيق هذا "الترف"، عبثاً نبحث عن كتاب، وعن جيل يهتم بـ"ترف" الكتاب.
نحن نعيش، صحّ. لكن، فقط، كالحيوانات. ثمة كلمة في الفرنسية تُغني عن كلّ شرح: survie.
في الخمسينات والستينات وصولاً إلى عشيات الحرب الكارثية، كان ثمة في لبنان، في بيروت تحديداً، حيّزٌ مجتمعي، اقتصادي، سياسي، مأمون إلى حدّ ما. وقد أفسح هذا الحيّزُ الرحب، المكانَ لنوعٍ من البحبوحة الروحية والفكرية والعقلية والإبداعية، التي أُعطي لها أن "تتمادى" تمادياً خلاّقاً، في الميادين كافةً، فكانت بيروت – المكان هي الإناء الأوسع الذي يحتضن كل الكينونات والموجودات، المادية والمعنوية. تالياً، كانت بيروت الثقافية ثمرةً لهذا التمادي، وصورةً مزهوّة تعكس رحابة هذا الحيّز.
لم يكن سرّ ذلك الزمن محصوراً في وجود كتّاب ومثقفين وخلاّقين كبار، لبنانيين، ومن العالم العربي. سرّ المسألة كان في ذلك الحيّز النوعيّ العام، الرحب، المأمون، المتعدد، السمح، النقدي، الحرّ، المتسع لـ"الآخر"؛ الحيّز الذي تُلتقَط إشاراته المغناطيسية المكهربة، فيستدرج، ويحتضن، ويختبر، ويزرع، وينجب.
لقد قُتِل هذا الحيّز قتلاً مبيناً (نحن أيضاً قتلناه)، على مدى العقود الأربعة الماضية. نحن ورثة هذا الحيّز القتيل. نحن نعيش بلا حيّز. وفي لا مكان. لا أرض تحتنا. لا سماء فوقنا. لا مختبر يرحب بنا. ولا فضاء يحتضن أفعالنا. فكيف لا نكون في طيش العدم؟!
هؤلاء الذين يديرون مكاننا العام، في الاقتصاد والاجتماع والسياسة والقيم، يستأصلون روحه، ويمرّغون خميرته، ويفرّغونه من كل قيمة وفاعلية ومعنى، ليجعلوه مكاناً صالحاً للكيتش والاستعراض والعنطزة السياحية، والعربدة التجارية والمالية والجنسية، لا مكاناً اختبارياً لتفجير الحياة وتوليدها.
هؤلاء الذين أعيّنهم تعييناً، وأسمّيهم فرداً فرداً، هم قوّادو المكان، وتجار هيكله. ينتزعون نخاعه الشوكي، يدمّرون طاقاته وقدراته وتفاعلاته، ويستهلكونه استهلاكاً سخيفاً، تافهاً، مريضاً، ليصبح مكاناً عدمياً.
إذا سألني أحدكم، الآن، ماذا يعني المكان العدمي، أجيبه بالآتي: المكان العدمي هو الأرض المحروقة. أو الأرض المفلوحة بالكيمياء. فكيف لأرض كهذه، أن تُزرَع، وأن ينمو فيها شيء صالح للأكل؟ وكيف لهواءٍ مصنّع أن يكون هواءً صالحاً للحبر والحياة والحرية؟!
المكان العدمي، هو ترميز للأرض المحروقة. ليس عندنا مكانٌ يعيش فيه انسانٌ سويّ، ولا كاتب، ولا شاعر، ولا نابغة، ولا فنان، أو سوى ذلك من الناس الطيّبين. وإذا عاشوا فيه، كما هم، ونحن، فاعلون الآن، فإن حياتهم تكون مفقودة العصب، وأعمالهم تطيش في الهواء المسموم.
في تشرنوبيل، تسرّب الموت من المفاعلات النووية، فأصبح المكان أرضاً محروقة غير قابلة للحياة.
بلادنا، هي شبيهة تشرنوبيل، رمزياً ودلالياً. لا تصلح إلاّ لصنّاعها، وحرّاسها، وهم هؤلاء الذين يستولون على حياتنا العامة وعلى حياتنا الشخصية على السواء.
أنظروا إلى لبنان، تعرفوا ماذا يعني المكان العدمي.
انظروا إلى حياته الوطنية، إلى كينونته السياسية، إلى سياسييه، إلى ملوّثي بيته ومسمّمي مائه وفضائه وهوائه وطعامه، وسارقي أمواله، وناهبي ثرواته المعنوية، وإلى مهجّري شبابه.
وانظروا إلى أسياده الدينيين، ورؤساء طوائفه ومذاهبه.
انظروا إلى طاقمه الديني - السياسي – المديني - الأمني – الاقتصادي هذا، وإلى مؤججي الأنوار الظلامية فيه، تروا ما آل إليه الكتاب والكتّاب.
هؤلاء، مع نظام الاستبداد البعثي الأسدي والتكفير الديني، أغلقوا الكتب، وأغلقوا الأمكنة والحياة نفسها. وفتحوا الكيتش على مصاريعه.
تحضرني مأساة تشرنوبيل، مثلما يحضرني في هذه اللحظة بالذات، صديقي الشاعر الإنكليزي، ت. س. إليوت، بقصيدته "الأرض الخراب". وهل نحن سوى شظايا تشرنوبيل؟! وهل نحن سوى بقايا الأرض الخراب؟!
* * *
يرث الشاعرُ المكانَ مثلما يرث الموت، وربما يليق به أن يرثي ضحاياهما. لكن مهلاً: لندع الموتى يدفنون موتاهم. فللشاعر، فقط، أن يُحدِث ارتجاجاً بنيوياً في لغة الوجود، وفي الوجود بالذات، وإن يكن هذا الوجود محض مقبرةٍ فحسب.
للشاعر أن يفعل ما يحلو له أن يفعل. لكنه لن يذهب إلى القبر بربطة عنقٍ سوداء. سيذهب إليه، فقط، بالحبر؛ بالحبر المفعم بأوجاع العشق والأمل والحرية!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية