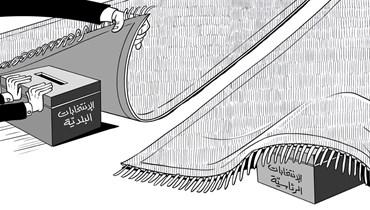سعيد عقل الشاعر الفحل الإله ... لسائلي أإلهٌ أنتَ؟ قلتُ بلى!
في العام 1912 ولد سعيد عقل. في العام 1935 أصدر "بنت يفتاح" أولى مجموعاته الشعرية. في تشرين الأول من العام 2000، أصدر مجموعتين شعريتين، الأولى "نحت في الضوء" (166 صفحة) والثانية "شرر" (216 صفحة) عن منشورات جامعة سيدة اللويزة. فيكون في ذلك وبلا منازع، شاعر القرن العشرين العربي، عمراً، بدليل أنه طوى نحواً من ثلاثة أرباع القرن الفائت شاعراً وناثراً وكاتباً وصاحب رأي، عاكفاً على الكتابة والعراك وسلّ السيوف وإثارة الغبار، معيداً صناعة الزمن ومحطاته ومعجمه وأدواته وتعابيره وبناه، على تألق في التعبير ووعي بالصنعة، شديدَي الوضوح، وعلى تكلّف صوغيّ وتركيبيّ وجماليّ، وعلى فحولة شعرية، تؤلف كلّها معاً لغته الشعرية التي كأنها أرادت لنفسها أن تكون خارج مشيئة التحوّلات، ناهلةً من معينها، في معزلٍ (أو في قلة اكتراث) عن كل ما يتحرّك ويتحوّل في أعماق هذه اللغة العربية وعن كل ما يحوطها ويحوط اللغات والشعر في العالم أجمع.
إذا شئنا ان نوهم أنفسنا بتناسي الزمن الراهن الذي صدرت فيه هاتان المجموعتان، ثم قرأناهما وأعدنا في الوقت نفسه قراءة بعض من مجموعاته الشعرية، أكانت في الغزل، أم في الوطنيات، أم في تكريم الشخصيات "الأفذاذ" رثاءً ومديحاً، أم في الذاتيات، فلن يكون في وسع أحد أن يتحدث عن ماض وحاضر في لغة سعيد عقل الشعرية. فاللغة تكون عناصرها المادية والمعنوية وتعيش في تاريخيتها الذاتية. وهي لا تني تجدد هواءها وترابها ونارها وماءها وتعيد صناعة اللحظة الشعرية. دأبها الإيحاء أن لا زمن لها لأنها تفترض أنها غير معنية بالحياة التي يغدر بها الزمن ويطويها وينزل بها ما لم ينزله عادة بكل ما هو عرضة للتبدّل والتحوّل.
كمال اللغة
اللغة، في هذا المعنى، هي على شباب دائم. ليست معنية بـ"العمر" الذي عاشته لأنها تغفله وتتناساه. كأنها لم تعش قط، بل هي تباشر حياتها للتوّ. إنها لا تصاب بوهن العمر والشيخوخة ولا تسلّم أسلحة استخدمتها في أحد الأيام، ولا تتدجّن أو تتروّض أو تعيد النظر في معجمها وبناها التركيبة، ولا تقترح عمارة أخرى (أو هنيهات) للقصيدة، تخالف العمارة المألوفة.
إنها على هذا المستوى هي اللغة – العالم، ولا عالم سواها. أو أن العالم الذي يوازيها هو عالم آخر لحياة أخرى ليست حياتها وليست معنية بهما. وهي لغة كاملة غير منقوص منها ولا منقوصة. أي أنها وصلت الى مرادها منذ البدء. بل هي بدأت كاملة ولن تتطلّع الى ما تضيفه على كينونتها، ليعزّز شعورها بالوجود، او لتغتني بما يقيها شر الطريق المسدود والضجر واليأس والحاجة والعوز وموت الخيال. ولأنها مقيمة في الكمال والاكتمال، تستطيع أن تمارس عيشها بذاتها النموذجية، وأيضا بما ينفحها به شاعرها وصانعها من "النماذج" التي يمكن أن تستعاد الى ما شاء الله والعمر. هذا النوع من الكمال، لا يخالجه اي إحساس بالبدايات او بالنهايات. لأن لا بدايات ولا نهايات. فهو – أي – الشاعر – إستثناءٌ "إلهي"، على ما سيقول في أحد أبياته، وقصيدته، تالياً، هي حالة وجود "إلهي" تسبح خارج الوقت الملتهم، ولا مدعاة الى "تطورها" أو تحوّلها.
تجميد زمن الحبّ تخصيصاً
نقول إنها الحالة الشعرية التي "تجمّد" الزمن وتستبقيه و"تبلّره cristallisation du temps، فهي التي بحسبها يتم تعليق كل الحوادث واللحظات والأعمار، مهما كانت تافهةً، بموضوع هذا الزمن. وإلا كيف يمكن ان نفسر الألق المثير للعجب في الغزليات التي لا تنمّ في أي لحظة على ان كاتبها هو على ما هو عليه من "عمر" وتجارب، وعلى انه كتبها الآن وفي هذه اللحظة! ليس الألق ألقَ التعبير والبناء فحسب، بل ألق المعاني وغوايتها الجسدية. حتى لكأننا – حين لا نتذكر ان الشاعر تسعينيّ الأعمار – نظننا أمام فتى تضجّ به الغوايات وتنزّقه وتطرّي عود عواطفه وتلهبه. فها هو يفتن بالمرأة، عرياً منسكباً، وقداً وقواماً وشالاً وخصراً وزنداً وشعراً وقبلةً وثغراً ونهدين وسريراً وعينين و... هلمّ. وها هو، مع هذه المرأة في جلسات إختلاء حميمة، شاهداً وبطلاً، عاشقاً ومعشوقاً، منخطفاً أو خاطفاً، يرصّع القول ترصيعاً أنيقاً ومغناجاً على مدى الصفحات والقصائد – الأبيات في "شرر" (من الصفحة 11 الى الصفحة 23 مثلاً، وغيرها كثيرُ في المجموعة نفسها)، كما في "وريقات منهنّ" ("شرر" من 147 الى 163) وفي "تمايد الخصور" ("شرر" من 165 الى 212) تنثال إنثيالاً شفيفاً ومعمارياً في آن واحد، فلا نكاد نعرف أنحن في أول القرن الحادي والعشرين أم في زمن "رندلى" الذي يعود الى منتصف القرن الفائت، وفي العام 1950 تحديداً؟ أفلا نتوهم ونحن نقرأ رنغانا (صفحة 83 من "نحت في ضوء") ورشا ورشا الثانية ورشا الثالثة (صفحة 101 – 113 الكتاب نفسه)، أنهن – ولِمَ لا! - نظيرات رندلى ودلزى ومركيان، آنسات ذاك الزمان الغابر وملهمات الشعر والهوى لدى شاعرنا سعيد عقل؟! و... ما همّ! ما دام العمر لا يتقدّم، والقلب لا يشيخ، والشعر هو هو، وما دامت الحياة لحظة خلود متكررة ومستولدة (لن نقول "مستنسخة")، على فتوة وبريق ساطع وإباء واستعلاء وهدوء بال و... اكتمال.
تجميد زمن البطولات والرثاءات والمدائح
إذا لم يكن الأمر هكذا مع الزمن "المجمّد" و"المتبلّر"، فبأي مشاعر ونكهات نقرأ أبيات الأمجاد والبطولات إذا لم نقرأها بـ"لغة" ذلك الصخب التاريخي، بل ذلك العبق الماضوي العريق الذي يدوّي ويُسمع صدى دويّه ليس بالأذن فحسب بل في تردّدات الضمير السعيد عقلي تحديداً! هكذا هي القصائد في فينيقيا ولبنان وبيروت وصور وصيدون وجبيل وطرابلس وقدموس وبركليس وهنيبعل وبرق السيف والنهى والكرامة والبعلبك وقانا والمجد وماذا الزمان والعلم والحضارة والحرف والأرز والبحار والإغريق واليونان، "عظيمةً"، و"خالدةً"، تزداد رسوخاً وتألّهاً ويعلو صخب تاريخها على الأعمار والصروف، فهل يعقل ان نقرأها بنت ساعتها الراهنة إذا لم نكن نقرأها "مجمّدة" و"متبلّرة" في الزمان، متخطية ويلات الألم والموت وغدر الأعمار ونوائب الدهور؟!
وكيف نقرأ القصائد في عبدالله العلايلي ومحمد مهدي الجواهري وإلياس أبي شبكة وفؤاد إفرام البستاني ونجيب جمال الدين وحسن كامل الصباح والعمالقة و"الأربعة خالقو أوروبا" (من مجموعة "نحن في الضوء")، وكيف نقرأ قصائده الخاطفات والسريعات، وخصوصاً منها "معاصري الأفذاذ" من صفحة 65 الى 92 في "شرر"، حيث يستذكر شاعرنا الكبير كلاً من شكري غانم وقيصر الجميّل وميشال شيحا وشارل قرم وصلاح لبكي والياس الحويك وعمر الأنسي ويوسف غصوب وشوشو وأمين نخلة وعبدالله العلايلي وعمر الزعني وعاصي رحباني ونبيه ابو الحسن ومصطفى فروخ وآخرين... اذا لم نقرأها ونستشف فيها، صوراً وتراكيب ورموزاً ومعاني، هاتيك التي كنا نستشفها من خلال قصائده التي كتبها في زمن سابق، في عمالقته، وخصوصاً في مجموعته "كما الاعمدة" التي نشرها في العام 1974؟! وقصائده هذه الرثائية – المدحية ليست رثاء قط. انها قصائد مديح. فهو لا يرثي هؤلاء الأفذاذ بل يخاطبهم معظّماً ومادحاً ومقرّظاً، بل لا توحي قصائده انها تترك العنان لدمعة او لألم، فالشاعر يأبى الوجع والألم و"التنازل" لعاطفة تنال من كبريائه.
بين غنج القصيدة ودلالاتها من جهة، وصلف المجد والعظمة والألوهة من جهة ثانية – والجهتان على رصف وحسن صوغ ودقة تركيب وعلى ابتعاد عن الطبع وتلمّس التكلف، وعلى تعقيد في البناء وتشييد العمارة – ثمة جسرٌ يردم هوة مفترضة بين الضفتين. جسر يستطيع في لحظة نسيان لـ"طبيعة" المرأة و"أنوثتها" مثلاً، ان يصل المرأة بالسيف، وهكذا لا يعود ثمة هوة فاصلة بل ثمة اجتماع امجاد يرفع تلك العمارة الشعرية. فلا ارتباك ولا تردد ولا ازدواجية ولا تناقض، بل هذا وذاك وهاتيك في اناء واحد هو القصيدة السعيد عقلية. انها القصيدة – العمارة، وانها القصيدة – الرمز، وانها القصيدة – المنحوتة، ويكفيها لكي تحيا أن تنصقل هكذا وأن لا تأبه، فتقوى بهذا على الزمن. قصيدة دأبها الصعوبة – كما الجمال – وهي تفتخر بذلك وتعلنه، فالصفحة البيضاء، ما هي إن لم تكن "سماء ربّك" مشكوكة بالنجوم (صفحة 28 من "شرر")، والشاعر لن يتوانى عن تحديد جمال المرأة وكيفية قبض الخاطر على بيت شعر، فكلاهما "صعب"، لكن هذه الصعوبة اشبه ما تكون بالصعوبات التي كانت تواجه البطل الصنديد عنترة غير أنه سرعان ما يتغلب عليها، وها هو يوضح كيفية تذليل الصعوبة والاستيلاء على المجد: "على أن لي في اخذ الاثنين/ دربة/ تفاوتا/ كحطم الموج؟ قسراً على الشط..." (صفة 32 من "شرر").
هذا كله مدعاة اجتراح لا مدعاة تكرار. فما تحفل به قصائده الأخيرة، ليس بأقل مما كانت تحفل به قصائده تلك، التي صنعت مجده و"جمّدت" الزمن فيه. "انا الصبا"، يقول سعيد عقل، "تخالني فتّ فيّ الوهن؟... /مُرّ على /زندي/ وعرّج/ على مهوى مزايانا.../ ابقى، ولو راحت التسعون تغمزني/ انا الصبا/ ما بقيت البدع مرمايا..." (صفحة 24 "شرر" وتتكرر القصيدة اياها في الصفحة 195 من "شرر" في عنوان "ما يكون الصبا"). فهو "فريد" و"صنو السيف" و"أعيش كالسيف" و"عبقري"، وشعره "رقص على حد السيوف". بل هو يذهب في تقريظ نرجسيته لدى تحديده الشعر الى حد تأليه ذاته: "لسائلي: "أإله أنت؟" قلتُ "بلى..." (صفحة 7 من "شرر")، فأي عجب اذاً في مصادرة الزمن واعادة "خلقه"، ومع الزمن اعادة خلق هذه اللغة الشعرية التي لا تكل عن "انتاج" القصائد وشقع الكلام شقعاً مرصعاً بالغار والمجد! إنها في اختصار مدهش جمالية المطلق التي يؤمن بها سعيد عقل في الألفين، مثلما آمن بها في ثلاثينات القرن الماضي وأربعيناته وخمسيناته وستيناته وسبعيناته...، من دون أن يشوب سيره الحثيث في طلبها أي وهن. وهل يصاب بالوهن مَن قوله: "لا تدعه الوهن يبلوك/ ولا/ ترضه بين نداماك كضيف/ واذا سيفك قل اكبر.../ وقلْ- ويك زندي/ تهيأ، /أنت سيف!" (صفة 194 من "شرر").
وظيفة النموذج
لكن هذه اللغة هي بسبب ذلك مشغولة في جد ونشاط بالمحافظة على ديمومتها. على أن ديمومتها هذه التي ترضى لنفسها التنويع على منوال أو على مناويل متعددة ومتناسقة، تمارس "وظيفتها" التاريخية وتعاود مواصلة هذه "الوظيفة" المتجددة والراهنة في الكمال، وذلك من دون أن تكون مدعوة الى اي تغيير جوهري او الى أي "خروج" على منطق "النموذج" – أكانت قصيدة طويلة أم سرب أبيات قليلة -، وفق ما ترتئيه ووفق ما يناسبها ويتماثل معها، مستعينة بما يؤاتيها من موضوعات وأفكار ولحظات ومناسبات.
في محافظتها على هذه الديمومة، باتت تشعر بالحاجة الى المواظبة على كثير من الصنعة والدربة كي لا يشوبها وهن، وخصوصاً كي "تبرهن" للآخر – القارئ أنها خارج الشيخوخة وخارج امتحان الزمن مطلقاً. فبهذه الصناعة المتدربة والخبيرة والدؤوبة "تخدع" الزمن وتتحايل عليه وتعبر حياله مكلّلةً بغارها، مجتازةً طريقها الملكي بالأبهة والخيلاء، بما تتصف به من كبرياء وشموخ وعزة واعتزاز وبسالة و"رجولة"، متفاخرةً على اللغات والشعراء، على غرار أهل الافتخار في كل مكان وزمان.
العمارة الشعرية وما وراء الرياضيات!
على أنها صنعة تأخذ بشغاف القصيدة وبتلابيبها. وهي ليست صناعة كلام فحسب بل هي بناء لا يعرف خللاً في أيٍّ من اجزائه، حتى لكأنه، وهو مصنوع بكيمياء اللفظ وشكلانيته وأسراره وصخبه وألاعيبه، يرتفع لبنةً لبنة ومداميك مداميك، قوياً وصلباً وشامخاً، لا تعتوره شائبة ولا ينال منه أي من جوانبه وأطرافه. فهو كلٌّ متكامل أو جبل واحد لا أجزاء فيه ولا صخور ولا فتات ولا فجوات او وهاد. انه بناء فحسب، والبناء يتكلف الظهور تكلفاً لأنه يأبى ببساطة التواضع. فهو زاخر بالحلى والمزينات اللفظية والبيانية، كلفٌ بها، يأنف الوداعة، يستدعي ما طاب له من بيان، تشابيه ورموزاً واستعارات وكنايات، فضلاً عما يستدعيه من اغواء وغوايات لفظية ومن تلاعبات بالجمل وايقاعاتها وتركيباتها وكيفية ترتيب الصيغ وتركيب الأشكال التي يختارها لزينة القصيدة. وهو دائماً سريع الحركة، يوهم بالتبسط والانسياب حيناً، لكنه يرمي روحه في خضم التفخيم والتعظيم والتأليه وكسر الجملة بالاستفهام أو التعجب أو النفي أو التأكيد، لا يبخل بمفاجأة مجلجلة ولا يتورع عن أي صخب وعنفوان.
والبناء الشعري هو إعمالٌ للتفكّر في القصيدة على أنها عملية رياضية، أو هي "ما وراء الرياضيات". فليس الشعر لعبة وجدان يمعن في استنزاف الروح ليطلع منها نبات الرؤيا الشعرية، بل هو صناعة وعمران وشغف بالعظمة لا يكلّ عزمها معاً، حتى وإن بدت القصيدة رخاماً تستعر النار على مقربة منه من دون أن يصطلي بها. مثل هذا التصور للشعر هو الذي يمنح الشاعر هذا الفائق من التكرار الأشبه ما يكون بالدوران الصوفي الذي يقوم الامتحان فيه لا على الاتحاد بالمعشوق والذوبان فيه بل على امتشاق سحر البيان وصيغ الجمل والألعاب والحركات والنجوم والسيوف وترصيع القصيدة بها. حتى لكأن هذه القصيدة، في لغتها وبنائها، هي هذا المهرجان الغنيّ والفتيّ، مهرجان الكمال والاكتمال بالذات. وهو مهرجان يحول دون "قراءة" القصيدة بالعين. فشعر سعيد عقل شرطه أن يُلقى ويُسمع اكثر منه للعين والتأمل. والاستماع اليه أحد اسباب جماليته الايقاعية والبنائية.
والقصيدة هي هي، في الماضي والحاضر توغل في التقدم داخل نرجسيتها ورؤاها وبنيتها لكنها لا تتقدم الى أي مكان او زمان، لأنها راسخة وثابتة شأن منطق الرمز وشأن المفاتيح – المصطلحات التي تلجأ اليها وتحتمي بعظمتها وتستضيء بمعانيها وتصطلي بنارها. وهي نفسها الآن وقبل خمسة وستين عاماً.
... وسعيد عقل يعيش في زهو الحرير (حريره) الأصيل وفي "البيت" الذي يصنعه من حريره هذا، ويرى الى الأيام عابرة بشعرها وشعرائها واختراعاتها وتحولاتها وعولمتها وحوادثها ونوائبها وفجائعها وآلامها وموتها وأمجادها وعثراتها، كأنها غير موجودة او كأنها تعبر في حياة أخرى وفي مكان آخر.
أليس هو القائل ايضاً "أشاعر أنتَ لم ينبّه؟... /ارنُ الى/ لعبات شعري التي أسكنتها القمما.../ أنا/ اذا لفظة حطّت على قلمي/ فاسمع بها/ عنه طارت/ بلبلاً رنّما..." (صفحة 99 من "شرر")؟ أليس هو القائل ايضاً "تبقى الحياة/ تفاهة/ حتى ارى/ انا نسرها/ وتشك فيّ جناح نسر..." (صفحة 129 من "شرر" 9)؟ فأين العجب في أن يصف نفسه بأنه الشاعر الفحل والإله؟!


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية