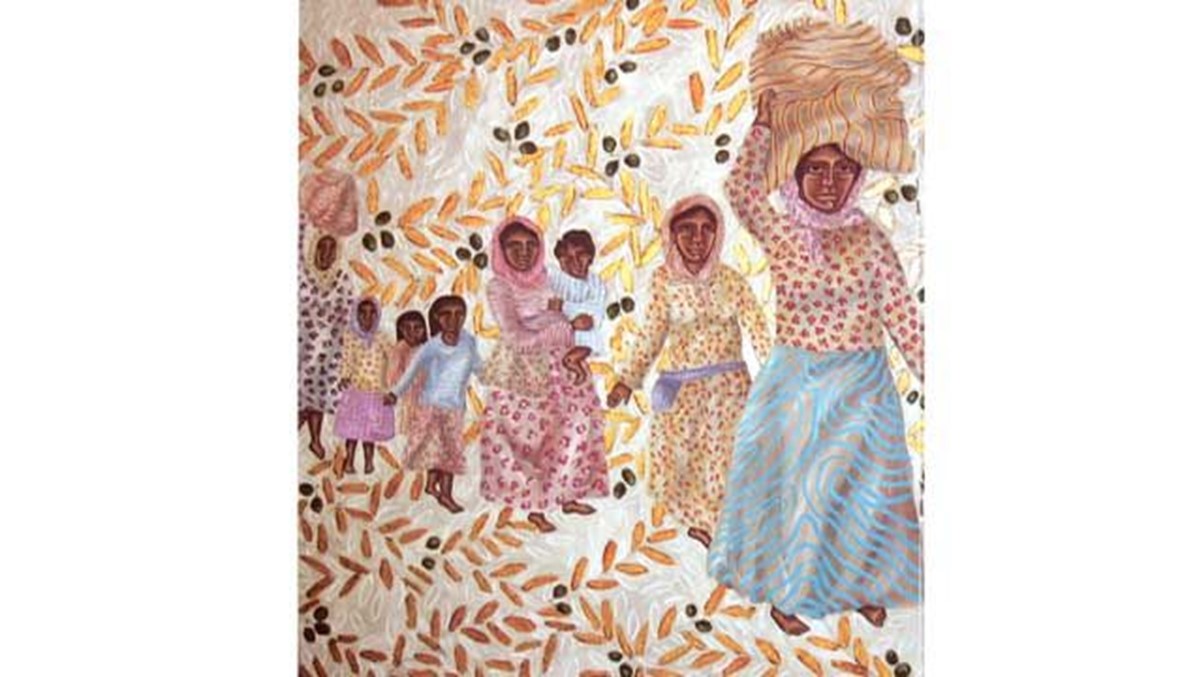في الحرب العالمية الثانية أنشأ مؤتمر موسكو 1943 لجنة للتحقيق في جرائم الحرب، ووقّع ممثلو الدول الكبرى في العام 1945 اتفاقاً يقضي بتأليف محكمة عسكرية لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد السلام، وهم من الذين أعدّوا الحرب العدوانية وجرائم إبادة العنصر أو العرق. اجتمعت لهذا الغرض محكمة نورمبرغ 1945-1946 وحكمت بالإعدام وبالسجن على عدد من كبار قادة النازية. كان ذلك ابتغاء مزيد من احترام كرامة الإنسان حتى في الحروب المرعبة بالذات. اليوم كالأمس، لا نزال نشعر كبشر بالحاجة العميقة إلى ما ليس منه بد، إلى محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في إسرائيل وما شابهها من أنظمة، إقليمياً ودولياً، باعتبارها عائقاً رهيباً في وجه الكرامة الإنسانية الفردية والجماعية.
إسرائيل هذه في الواقع، ليست سوى كيان صهيوني يستند إلى خرافة سموّ العرق اليهودي وفرادة إسرائيل كبرهان على حضور الإله في التاريخ، وغير ذلك من اعتقادات مريضة تشبه في الصميم اعتقاد هتلر بتفوق العرق الآري الذي جعل موقع ألمانيا ومكانتها "فوق الجميع".
نضم صوتنا إلى كل الأصوات المطالبة بفتح تحقيق دولي في شأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل ولا تزال، وفي شأن مقتل الفلسطيني محمد أبو خضير حرقاً وهو حي، والتحقيق أيضاً في شأن مقتل ثلاثة شبان إسرائيليين بعد اختطافهم على يد حركة "حماس" الفلسطينية لأيام بحسب زعم الإسرائيليين، تلك الرواية الإسرائيلية الصرفة التي لم تتثبت من صحتها أي جهة مستقلة حتى الآن، والتي اعتقلت إسرائيل على إثرها المئات من الفلسطينيين، وإليها استندت على ما يبدو، لتبرير عدوانها الوحشي الأخير على غزة؛ القطاع الذي استهدف فيه القصف الإسرائيلي المدنيين الآمنين في بيوتهم، والمدارس، المساجد، المستشفيات...، وارتُكبت مجازر في حق عائلات بأكملها.
كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت حتى يوم 30 تموز 2014 مقتل 1232 شهيداً وسقوط أكثر من 7000 جريح، وقد سوِّيت أحياء بأكملها في الأرض، كحي الشجاعية شرق غزة – على سبيل المثال لا الحصر- الذي قُصف في العشرين من شهر تموز وراح ضحية القصف أكثر من 70شهيداً، وقد رفضت إسرائيل حينئذ مجرد هدنة حتى، لمدة ثلاث ساعات لإجلاء الجرحى والمصابين والقتلى، بل منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الحي. قصفٌ طال عائلات بأكملها واستهدف صحافيين ومدارس ومأوى عجَزة. بعد انتشال الجثث خلال "الهدنة الإنسانية" يوم 27 تموز ارتفع عدد الشهداء في الحي إلى 120.
بحسب تقديرات الأمم المتحدة، ثمانون في المئة من الضحايا في غزة هم من المدنيين. قصف المدنيين جريمة حرب لا يُقبَل في صددها أيُّ نوع من الأعذار والذرائع وفق القانون الدولي. لنا أن نستشهد ببعض ما صرّحت به شخصيات إنسانية عامة ومنظمات حقوقية وتقارير دولية. في جلسة لمجلس حقوق الإنسان انعقدت منذ أيام، اعتبرت نافي بيلاي أن "الحرب على غزة انتهاك للقانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين". أما منظمة "هيومن رايتس ووتش" فقد أكدت مراراً: "على إسرائيل أن تكفّ عن هجماتها غير القانونية على غزة"، وطالبت منظمة "أطباء بلا حدود" بوقف استهداف المدنيين. وفي العودة إلى تقرير غولدستون 2008-2009 جاء: "الحصار جريمة حرب في القانون الدولي ويجب رفع الحصار عن غزة".
ترى لماذا يخاف الإسرائيليون التوجه إلى المحاكم الدولية؟ إن كانوا بريئين لماذا يخافون؟
* * *
بعيداً من الألعاب اللغوية السمجة التي طالما أطلقتها إسرائيل على عملياتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل: "عمود السحاب"، "الرصاص المثقوب"، وأخيراً "الجرف الصامد"، العملية التي بدأت على غزة يوم 7 تموز 2014، والتي ارتأت إحدى السيدات من أهالي غزة في مقابلة إعلامية، أن تسمّيها "حرب البيوت"؛ لا نظن مفردة "حرب" حتى، منصِفة أو قادرة على وصف الواقع بدقة. ما يجري في غزة عدوان غاشم وغادر. لا حرب متكافئة بين طرفين ندّيْن، متأهبَيْن، ومجهزَيْن عدّةً وعتاداً بشكل متكافئ. بل إن التضخيم من القدرة العسكرية للمقاومة الفلسطينية من شأنه، كما نعتقد، أن يوقع المزيد من الضرر بالفلسطينيين، وما صدور بيان من مجلس الأمن يدعو فيه "كل الأطراف" إلى وقف إطلاق النار، سوى دلالة على أنه من غير المنطقي، ومن غير الأخلاقي ولا الواقعي، أن يجري الحديث هنا عن "طرفين" ندَّين متقاتلَيْن. إذ إسرائيل دولة احتلال، وهي طرف "مهاجِم"، لديه ترسانة ضخمة، مجهَّز بجيش وعدة وعتاد، وبـ"أحدث" الأسلحة وأكثرها "تطوراً"، بينما الفلسطينيون المقاتلون هم "مقاومون"، لا يملكون سوى القليل من السلاح. وفي حين تقتل إسرائيل مدنيين ومسنّين وأطفالاً ونساء وأبرياء، تقتل المقاومة الفلسطينية جنوداً إسرائيليين. في تطور يُعتبَر إيجابياً في الخطاب السياسي لـ"حماس"، أكّد قائدها خالد مشعل في خطاب بعد أيام من بدء العدوان على غزة، أن المقاومة لن تستهدف المدنيين في إسرائيل. في هذا يتبدّى شرف المقاومة الفلسطينية من حيث هي تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية، في قبالة جيش احتلال تنعدم لديه القيمة الإنسانية والمبدأ الأخلاقي، ويستهدف مدنيين وأماكن مدنية ودينية. حتى أن ثمة فيديواً يُظهر قصفاً إسرائيلياً على مقبرة في رفح جنوب غزة! لا تكتفي إسرائيل على ما يبدو، بقتل الحياة، بل تريد قتل نقيضها أيضاً، لتمسي بذلك نموذجاً للعدم، للخواء، للحقد المطلق.
* * *
يريد الإسرائيليون غزة منطقة منزوعة السلاح، يوافقهم في ذلك الأميركيون خصوصاً، مثلما يوافقونهم في اعتبار المقاومة الفلسطينية مجرد "منظمات إرهابية". يريد الإسرائيليون تدمير الأنفاق في غزة، وتنسجم مع هذه الإرادة السلطات المصرية التي تريد أيضاً تدمير الأنفاق وتدمير التيارات الإسلامية دفعة واحدة. في خصوص السلطات المصرية، سوف يسجّل التاريخ أن العسكر في مصر قد أغلقوا معبر رفح في وجه الجرحى الفلسطينيين يوم 11/7/2014، بحجة أنه يوم جمعة وهو عطلة رسمية! لكن الشعب الفلسطيني يريد الحرية أولاً، والانعتاق. الناس في غزة يريدون أن ينفتحوا على العالم الخارجي وألاّ يبقوا محاصَرين محكومين بمنفذ برّي وحيد يفتحه صاحبه متى يشاء ويغلقه متى يشاء؛ معبر رفح أعني. غزة على البحر، ومن حقّ أهلها أن يتمتعوا بممرّ بحري يصلهم بالعالم، وأن تكون لديهم موانئ ومطارات، وكل ما هو لائق بعيش حرّ كريم (كيف يملك قصب السكر في فلسطين والبلاد العربية كافة، كلَّ هذه الحلاوة ويشرب الناس فيها الشاي مُرّاً؟!). أما آن أوان زمنٍ تكون فيه الأولوية للأخلاق لا للسياسة؟ أو تتوازى فيه الأخلاق مع السياسة؟
إسرائيل عدوّ بالضرورة لكل توجّه أو جهد وحدوي
ثمة غايات ينزع إليها الإسرائيليون عبر عدوانهم المستمر على الفلسطينيين، لعل أبرزها، تفتيت الصمود الفلسطيني وضرب أي محاولة من شأنها لمّ شمل الفلسطينيين وتعميق أواصر الوحدة والأخوّة بينهم. على ضوء هذا، يمكن فهم العدوان الأخير على غزة القاصد، من جملة مقاصد، إلى ضرب الحاضنة الاجتماعية للمقاومة الفلسطينية. يبدو ذلك من خلال الخطاب الإعلامي الإسرائيلي الزاعم أن "حماس" تتخذ من المدنيين دروعاً، وتحتمي بالمساجد وتتخذ مواقع تدريب بالقرب من المدارس والمستشفيات. يريدون ضرب المصالحة الفلسطينية واتفاق القاهرة 2012 الذي أفضى إلى تشكيل "حكومة وفاق وطني". الحكومة التي باتت محلّ تحريض من "الساسة" الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي، كون الانقسام الفلسطيني كان في السابق أكبر انتصار استراتيجيّ لإسرائيل.
بصرف النظر عن الاختلاف الإيديولوجي بين "فتح" التي تفضّل التفاوض و"حماس" التي تنحاز إلى المقاومة؛ فإن "حكومة الوفاق الوطني" – كما يقول الفلسطينيون- هي إنجاز، كونها حكومة تكنوقراط، تضمّ خبراء وأكاديميين. الحكومة ليست "فتحاوية" ولا "حمساوية". هكذا يصبح من السهل فهم تصريحات، من مثل تصريح ليبرمان في مطالبته "المجتمع الدولي" بالضغط على "حماس" في شأن عدم مشاركتها في الحكومة الفلسطينية. وهذا الأخير كان قد هدّد عام 2009 باستعمال قنابل تؤدي إلى عد السماع بغزة مرة ثانية!
أحرجت المصالحة الفلسطينية إسرائيل، على ما يظهر، وكشفَت أوراقها، لذا افتعلت الحوادث قبل عدوانها على غزة، ثم باشرت العدوان. الحلّ الدولي مبنيّ على إقامة دولتين، إلا أن الإسرائيليين يجيبون: ليس هناك شريك فلسطيني (في "اعترافاتها" ترى غولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل سابقاً أنه "لا يوجد شعب اسمه شعب فلسطيني")! هناك وزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون الاعتراف بوجود شعب فلسطيني حتى. ألهذا الحد وصل العمى السياسي الإسرائيلي؟ لقد دمّر الإسرائيليون العملية السلمية وتحدّوا العالم وخرقوا قوانينه. ينهج الإسرائيليون سياسة التقسيم من أجل السيطرة، يريدون ضرب الوحدة الفلسطينية لكي يقولوا للعالم: ما من طرف فلسطيني موحَّد لكي نفاوضه، ولكي يوسِّعوا المستوطنات. لماذا بنى الإسرائيليون الجدار (نظام الأبارتايد) في الضفة الغربية؟ يريدون من الفلسطينيين إنكار تاريخهم. يريدون اقتلاعهم من جذورهم وطمس هويتهم (فرادتهم). إسرائيل كيان غاصب ومغتصِب. "دولة" لا تعرف حدودها ولا تريد أن تعرف. في "ضوء" هذا كله وأكثر، يمكن فهم قول لـتسيبي ليفني: "لن نقول لكم أبداً أين حدود إسرائيل". في المقابل، يصبح لفلسفة فيخته "أنا أقاوِم؛ إذاً أنا موجود" كل المعاني على أرض فلسطين. أرض الفلسطينيين.
في الدعائية الإسرائيلية
يمكن في صدد الدعائية هذه، ملاحظة تجلّيها في موضوعين أساسيين، يمكن عنونة أحدهما بـ"سياسة المسكنة"، وثانيهما بـ"سياسة الاستعلاء".
1
دعونا لا نسافر بعيداً في عالم التنظير والمفاهيم المجردة، ونستلّ مباشرة من الواقع، أمثلة من شأنها أن تكون دالاً ومدلولاً في آن واحد على "سياسة المسكنة" الإسرائيلية. "فُرضت الحرب علينا"، بهذا التعبير يحاول الإسرائيليون إيهام العالم، الغربي خصوصاً، بأنهم "مساكين"، كانوا قابعين في بيوتهم آمنين هانئين قبل أن يباغتهم العدوّ بجيش كامل العدة والعتاد!، في حين أنهم حضّروا للحرب وجهّزوا لها وأعَدّوا. افتعلوا الحوادث، وحددوا الخطاب الدموي اللازم لتبرير الحرب سياسياً وإعلامياً. يقولون: "إسرائيل تستخدم الصواريخ لكي تحمي شعبها، و"حماس" تحتمي بشعبها لكي تحمي صواريخها". يقولون هذا لكي يغدو قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والبيوت، مقبولاً. لكي يمسي قتل الأطفال والنساء والأبرياء المدنيين العزل مستساغاً. لكي يقتلوا كل شعور إنساني، وكل تعاطف مع الفلسطينيين بالنسبة إلى مَن يتابع الحدث أو الخبر من خارج المشهد على الأرض.
قول دعائيّ من مثل "نواجه عدوّاً شرساً"، لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، يدفع البعض، إلى المساواة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، كأنهما في حرب متكافئة. وعندما يقول نتانياهو أيضاً: "أمامنا مهمة واحدة، وهي مكافحة الإرهاب"، المهمة التي بات معلوماً أنها ذريعة أنظمة الاستبداد والعسكر والطغيان حول العالم، في قمع الحريات وسحق الكرامات وسلب حقوق الشعوب في تقرير مصائرها، فإن ذلك القول، من شأنه الإيحاء بأن إسرائيل دولة حقّ وقانون تحارب الإرهاب، في حين أنها دولة قامت على الإرهاب وتأسّست عليه، فتاريخ عصابات الهاغاناه (مثلاً)، التنظيم العسكري للحركة الصهيونية، حافل بالإرهاب، بذبح الأبرياء، باستعمال الوسائل القذرة كافة من أجل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وبيوتهم، وتشريدهم. يتحدثون عن تنظيمات إرهابية، بينما حزب "الليكود" (مثلاً أيضاً) يوازي أي تنظيم إرهابي في تطرفه وتشدده وتعصبه.
يحضّ التفكير النقدي على الإمعان في التمييز بين نقل الخبر والدعاية، بين الواقع والدعاية، بين المعرفة الناضجة وصوغ الخبر أو صناعته، بحيث يكون لصالح مَن يروَّج له. وعليه، فإن "التحذيرات" الإسرائيلية التي من شأنها تنبيه المدنيين الفلسطينيين قبل القصف، والتي دأب الإسرائيليون على الحديث عنها إعلامياً منذ بدء عدوانهم الأخير على غزة، يفنّد الواقع كذبها. وما استشهاد عشرة أطفال في متنزه بمخيم الشاطئ غرب غزة في أول أيام عيد الفطر، يوم استجابت المقاومة الفلسطينية لدعوة الأمم المتحدة للدخول في هدنة مدتها 24 ساعة مراعاةً لمناسبة العيد، الهدنة التي رفضها الإسرائيليون أو لم يردّوا في شأنها، ما تلك الواقعة سوى دليل واحد و"بسيط" على كذب الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، وصدق الوقائع التي تتحدث عن جرائمهم. بعض الأهالي في غزة وصفوا المنشورات التي قال الإسرائيليون إنهم وزّعوها لكي يبتعد المدنيون عن مواقع "حماس" ومراكزها، بأنها "مثيرة للذعر لا التحذير".
2
تقتضي "سياسة الاستعلاء" الإسرائيلية بذل القسم الأعظم من الطاقات في دعائية تصوّر إسرائيل نموذجاً في الديموقراطية، والتعايش مع الآخر، والسلام. نموذج متحضّر يصرف طاقات هائلة في مجالات التعليم والصحة والفن والثقافة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في قلب "شرق أوسط" متخلف، جاهل، دموي، يمور بصراعات دينية طائفية مذهبية وإثنية. غير أن كل التجارب والوقائع التاريخية أثبتت ولا تزال، مذ تمّ "زرع" إسرائيل في قلب العالم العربي، أن السمة الرئيسة للصهاينة هي العدوانية وكراهية الآخر. من الإسرائيليين وحلفائهم، الأميركيين خصوصاً، تعلّمت الأنظمة العربية كيف تسحق شعوبها وتقمع الحرية والفكر والإبداع والثقافة والفن والمعرفة، أو محاولة مهمّة وجادة للنهوض باقتصاد البلدان العربية والتعليم والتنمية. ما جرى ولا يزال في ظلّ ثورات "الربيع العربي" مثال واضح على ذلك.
يقول الإسرائيليون إنهم دعاة سلام، صنّاع نهضة، وروّاد حداثة وديموقراطية في المنطقة. لكن في الأمس القريب، بعد أيام قليلة من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كان "صندوق النقد الدولي" قد قدّر خسائر الاقتصاد الإسرائيلي جرّاء هذه الحرب، بـ 546 مليون دولار. يتبجّح الإسرائيليون في خصوص إدخالهم سيارات أغذية إلى قطاع غزة، وهُم في الأصل، ومن قبلُ، يأخذون ثمن هذه المواد وغيرها من الفلسطينيين!
معلومٌ أن إسرائيل قامت على المساعدات (لكي لا نقول على التسوّل)، وليس من شأن من يتلقّون مساعدات من دول كالدول الغربية مثلاً، تلك الدول التي تَعتبِر إسرائيل جزءاً منها، أو يدها الممدودة إلى قلب الشرق الأوسط، إحراز إنجازات ترتقي بأحوال البشر وأوضاعهم. فمعلومٌ أيضاً أنه ليس من مصلحة إسرائيل ولا الغرب، ولا من مصلحة المستبدين الشرقيين والظلاميين كافة أيضاً، أن تكون في الشرق الأوسط ديموقراطية وحرية ونماء ورخاء. أمضت غولدا مائير (مثلاً) باعتبارها واحدة من زعماء الحركة الصهيونية، مذ جاءت إلى فلسطين عام 1921، أمضت حياتها مسافرة تجمع الأموال، لا لكي تبني "حضارة" اسمها إسرائيل، بل لكي تقوّض الحضارة في "الشرق الأوسط". ويبدو أن التقوقع، والإحساس الدائم بالعزلة لدى الإسرائيليين، يستدعي في المقابل ردّ فعل مضاداً دائماً بحثاً عن القوة والحماية.
في سياق "سياسة الاستعلاء" نفسها، يمكن أيضاً إدراج استراتيجيا "الإنكار أو التضليل حين تكشف الحوادث عن جوانب ضعف لدى الإسرائيليين" ثم "العدول عنهما حين لا يعود هناك جدوى منهما". نطرح على سبيل المثال: حين أسرَت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حماس"، الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون، بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أنكرَ سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة ذلك، لكن الإسرائيليين عادوا في ما بعد واعترفوا بأسر الجندي. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد استفزّ في أكثر من مقابلة، بعض سائليه من الإعلاميين، القاصدين إلى التعرّف منه إلى أعداد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جرّاء عدوانه على غزة. استفزّهم عندما راح يتهرّب من الإجابة محاولاً تغيير الهدف من السؤال، حارفاً الحديث عن مساره. كان ذلك قبل أن يعود الإسرائيليون ويعترفوا بمقتل جنود من جيشهم، وصل عددهم في يوم 29 تموز إلى 52 قتيلاً بحسب ما تم تداوله إعلامياً.
عن "ضبط النفس" و"الدفاع عن النفس" الإسرائيليَّين
1
يبدأ نصبُ الفخاخ للقارئ، الغربي على الأرجح، من العنوان: "اعترافات غولدا مائير". إذ يوحي بأن مؤلفته مائير نفسها، سوف "تعترف" بما قد لا يخطر على بال، كون كلمة "اعتراف" قد تحيل في معنى ما على دهاليز وكهوف وحُفَر وبواطن وأعماق، كما قد توحي بأن "المعترِف" يريد الكشف عن أخطاء وكوارث يشعر بضرورة البوح بها، كنوع من التكفير عن إثم أو آثام. لكن القارئ، النقدي على الأغلب، سوف يكتشف على مرّ أكثر من ثلاثمئة صفحة أن الكتاب، إن هو سوى ضرب من ضروب الترويج للصهيونية يكرس لها مفهوماً وواقعاً كحركة عنصرية تستند إلى اعتقادات زائفة وباطلة من أجل إمرار احتلالها أرض الفلسطينيين والمضيّ في مشروعها الاستطياني التوسعي. ما من فكر أصيل وعميق في الكتاب، ما من ثقافة، ولا معرفة، ولا مستندات تاريخية موثوق بها تدعم المزعوم فيه. ولا أخلاق أيضاً. بل عنصرية وتعصّب وكراهية لا تتوانى عن إلصاق سمة الإرهاب بالعرب دونما أدنى إحساس بالخجل، أو حد أدنى من المعرفة. فإن كان يصحّ وصف تنظيم ما أو حزب ما، أو فرد ما بالإرهاب، فهل يصحّ – علمياً على الأقل- وصف قومية بالإرهاب؟!
في الصفحة 134 من الكتاب المذكور، ترجمة عزيز عزمي، دار "التعاون". تتحدث المؤلفة عن "سياسة ضبط النفس" فتعتبره "أصعب من الردّ والانتقام". وترى أن "الهافلاغا" هو "الأسلوب الأخلاقي الوحيد والأوحد الذي يجب اتّباعه". ثم تقول إن "الهاغاناه استخدمت سياسة ضبط النفس". معلوم أن الهاغاناه شأنها شأن عصابات أرغون وشتيرن، لم تتوان عن استخدام أشد الفظاعات والفظاظات ضد الفلسطينيين، من أجل حملهم على مغادرة أراضيهم وبيوتهم. (غالباً ما يكون المبالغون في شأن التعقل والهدوء على مستوى الخطاب، المفرطون في الحديث عن القيم الإنسانية والأخلاقية السامية الرفيعة المستوى، على المستوى العملاني الواقعي نقيض ما يقولون. ويبدو أن الخواء أو النقص الهائل في القيمة المعنوية الذي يعانيه هؤلاء حيال الآخر، يدفع إلى تعويضه بشكل هائل في المقابل، ومبالَغ فيه على صعيد الخطاب).
أياً يكن، في الإمكان استنباط بؤس "ضبط النفس" الذي تتحدث عنه مائير، وزيفه، من خلال ما يجري الآن في غزة. يفترض ضبط النفس الممارَس من طرف، أن هناك طرفاً آخراً يعمد إلى الاستفزاز أو الابتزاز، ومع ذلك يبقى الطرف المستفَز هادئاً، متفهّماً، ولا يردّ بالمثل. لكن لنمعن قليلاً: فلنفترض جدلاً أن الرواية الإسرائيلية في شأن مقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة صحيحة، هل "ضبط النفس" هنا يستدعي الرد بعدوان رهيب من جانب "المستفَزّ "على "المستفِزّ"، يطال أطفالاً ونساء وشيوخاً وأبرياء، ويعصف بالمدارس والمساجد والمستشفيات، ويحوّل مدينة إلى رماد وركام؟! أهذا هو "الهافلاغا"، الأسلوب "الأخلاقي الوحيد والأوحد الذي يجب اتّباعه"، كما درّست مائير وعلّمت؟! يبدو أنها كانت سلفاً "صالحاً" لخلف طالح. ألا يفترض "ضبط النفس" مثلاً، تفكير "المستفَزّ" في ضرورة فتح تحقيق رسمي قانوني من شأنه بيان الحقيقة والاقتصاص من "المستفِزّ" بعد التحقّق من ارتكابه الجرم فعلاً؟
عندما تؤكد تل أبيب رفضها الضغوط الدولية كافة في شأن وقف عدوانها على غزة، هل يعني هذا "ضبط نفس"؟ ترى، لماذا طالب مجلس الأمن يوم 10 تموز نتانياهو بـ"ضبط النفس" إذا كانت "النفس مضبوطة"؟ ولماذا حضّ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إسرائيل بعد اثني عشر يوماً على "ضبط النفس" أيضاً؟
2
ثمة بداهة تقول: إن الواقع تحت الاحتلال هو مَن يكون في موقع "الدفاع عن النفس" لا المحتل. لكن ليس مستغرباً بالنسبة إلى إسرائيل، على ما يبدو، باعتبارها دولة احتلال، اعتادت خرق القوانين الدولية والمنظومات الأخلاقية والإنسانية، أن تخرق بديهيات من هذا الطراز، وتنسب إلى نفسها صفة "الدفاع عن النفس" من دون أن يكون لها أصلاً أي حق قانوني دولي في ذلك. وما دامت الحكومات الغربية تعتبر إسرائيل جزءاً منها، فلا غرابة أيضاً في أن تؤيد "حق" إسرائيل في "الدفاع عن النفس"، بدلاً من أن تنصاع إلى شعوبها، وفق ما تقتضيه الديموقراطيات في تلك البلدان. إذ تجدر الإشارة هنا، إلى أن العديد من العواصم الغربية شهد احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.
في كل الأحوال، لا تنفصل "سياسة المسكنة" الإسرائيلية عن خطاب "الدفاع عن النفس". إنهما وجهان للعملة ذاتها، ومن خلالهما على مستوى الخطاب الإعلامي، ومن خلال الحرب والعدوان على الأرض، تحاول إسرائيل "انتزاع" "الاعتراف" بها!
الضحيّة والجلاّد
ما فعله الإسرائيليون ولا يزالون باعتبارهم "ضحية"، دفعتهم عقدة "الاضطهاد الكوني" لأن يمسوا "جلاّدين" على طريقة جلاّديهم، محوّلين بذلك الفلسطينيين إلى "ضحية" لهم، قد يجعل الأجيال القادمة من الإسرائيليين "ضحية غير مباشرة"، فيعود أولئك ضحايا بعدما صاروا جلاّدين.
على صعيد فردي، قد يكون هناك إسرائيليون أو يهود متنوّرون يكرهون أن يقع الظلم الذي عانى منه شعبهم على شعب آخر، أي الشعب الفلسطيني، ويشمئزون من الخلاص من شعورهم بالنبذ والإقصاء، ومن ثم تحقيق الذات من خلال استباحة دماء الفلسطينيين وكراماتهم، وعلى أنقاض بيوتهم، ويفضّلون ألاّ يكونوا جلاّدين ولا ضحايا بالدرجة نفسها. لكن يبدو أن هناك بالفعل "مأساة مبرمَجة تاريخياً"، وهو الوصف الذي حاول من خلاله محمد أركون، في حوار أجراه معه سليمان بختي، منشور في "النهار" بتاريخ 13 نيسان 2002، مقاربة ما يحصل في فلسطين اليوم. ويعني بذلك، كما جاء في معرض إجابته عن سؤال محاوِرِه حول المقصود من الجملة تلك، أن "قوة تاريخية لا تزال تعمل على إنتاج مصيرنا التاريخي وتسييره، ليس بعد سيطرة الاستعمار في القرن التاسع عشر وإلى يومنا هذا فحسب، بل بدأت هذه القوة تعمل في إنتاج تاريخنا، على ما أعتقد، منذ القرن الرابع عشر – وهناك دلالات كثيرة على ذلك". ثم يضيف متداركاً: "ولكن يجب أن يكون هناك اليوم في فلسطين، فلسطينيون يطرحون الأسئلة في قلب المأساة".
العلاقة بين الضحية والجلاد، كالعلاقة بين السيد والعبد، هي علاقة تضايف، لا يُفهم وجود أحدهما إلا من خلال وجود الآخر، بانوجادهما معاً. وعليه، لا تتحقق الكرامة الإنسانية من غير انعدامهما معاً.
ليس دينياً
في اجترار مستمرّ لخطابات الماضي، ومع تسلّح مستمر بعقدة "الاضطهاد الكوني"، يحاول الإسرائيليون دوماً تصوير السياسي على أنه ديني. لكن الأوروبيين لم يحلّوا "المسألة اليهودية" (مثلاً) لأسباب دينية، ولم يعمدوا إلى "إنشاء" دولة خاصة باليهود في فلسطين، لأن اليهود يهود كما يعتقد الإسرائيليون. بل يعتقد البعض ممن يقرأون التاريخ قراءة علمية، أن الأوروبيين نزعوا إلى التخلص من اليهود، بعد ولوجهم عصر النهضة، أي بعدما انكمش التفكير اللاهوتي، وساد طراز آخر من التفكير، براغماتي عملاني تجريبي، وصار يُنظر إلى اليهود باعتبارهم عبئاً على الاقتصاد والموارد. على المنوال نفسه، يسعى الإسرائيليون دائماً إلى تصوير صراعهم مع الفلسطينيين والعرب على أنه صراع ديني، مع أنه ليس دينياً، في جوهره على الأقل.
في مقال تحت عنوان "إسرائيل لا تفعل ولا تتكلَّم باسم كلِّ يهوديّ"، يعود إلى العام 2006، ترجمة نسرين نضير، لا يخفي كاتب المقال أندرو بنجامين، منذ البداية، غضبه حيال مزاعم إسرائيل وسياساتها. يقول: "أكتب بصفتي يهودياً وعضواً في كنيس. أكتب بصفتي شخصاً لا يزال عملُه الأكاديمي يعالج مسائل الهوية اليهودية وإرث "المحرقة". مع ذلك، أكتب مع حسٍّ متنامٍ بالعار. ومصدر هذا الشعور بسيط: تزعم إسرائيل أنها تواصل التصرف باسمي!". لا يخفي الكاتب غضبه أيضاً حيال المماهاة بين الديانة اليهودية والسياسات الإسرائيلية، وهي كما يقول "سياسات تتجلى في جَرْف المنازل في غزة وقصف المدنيين في قانا". يتحدث الكاتب عن استغلال إسرائيل للمحرقة، واستعمالها "لتدعيم حالة جيوسياسية معينة". ثم يخلص في مقاله إلى نتيجة تنطوي على تحذير: "ما لم يصبح اليهود مستعدِّين للتعبير عن الحاجة إلى وضع حدٍّ لمماهاة اليهودية بإسرائيل، سيزدهر العداء للسامية. وما لم يصبح اليهود مستعدِّين للقول إن المحرقة وإرثها ليسا من اختصاص دولة قومية ولا يبرِّران الصهيونية بالأحرى".
بقي أن نسأل: في ضوء تظاهرات حاشدة شهدتها الضفة الغربية مثلاً، بل سقوط شهداء فيها يوم السادس والعشرين من تموز الذي سُمّيَ "جمعة الغضب" تعبيراً عن السخط حيال العدوان الإسرائيلي على غزة. يومٌ دفعَ الصحافي الإسرائيلي يون بن يشي إلى القول: "يجب إنهاء الحرب والبحث عن مخرج بعد اشتعال الضفة الغربية". أو في ضوء إضراب عام عمّ الجليل والنقب داخل الخط الأخضر، وإضراب تجاري عمّ الضفة الغربية بما فيها القدس، وهذه الأخيرة شهدت أيضاً تظاهرات مناهضة للعدوان الإسرائيلي في اليوم الأول من عيد الفطر. في ضوء ذلك كله وغيره، هل انتفاضة فلسطينية ثالثة، تنقل فلسطين من بؤرة للمشكلات إلى مكان فسيح للحلول، أمر وارد؟
كاتبة سورية


 اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اشترِك في نشرتنا الإخبارية